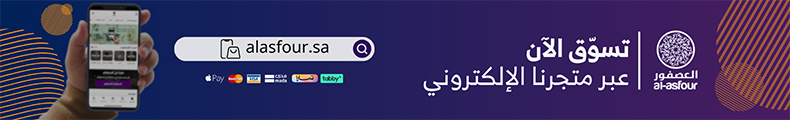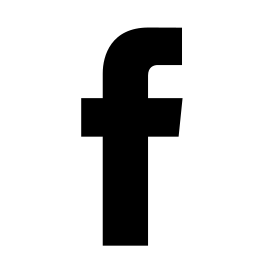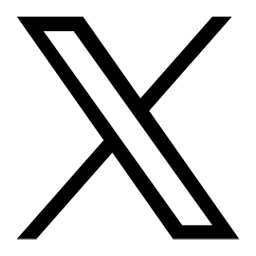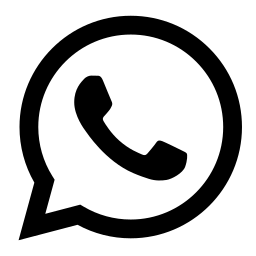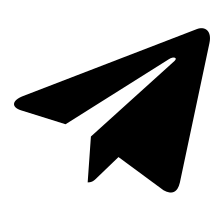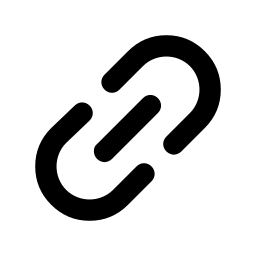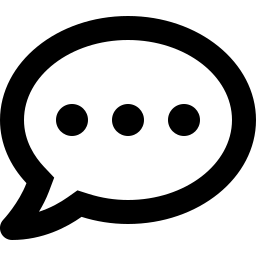التواصل الإنساني بين تقريب القلوب وإثارة الضغائن
تمر الحياة البشرية في مرحلة دقيقة من التاريخ الإنساني، بفعل التطور المذهل والتقدم المطرد والمتسارع في مجال تقنيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وسرعة التواصل، والتي أدت إلى اكتساح وزعزعة دور وسائل الاتصال والمعرفة التقليدية والمتعارف عليها، حيث اختزلت اليوم المسافات، وأصبحت الأرض على سعتها وكبرها وكأنها قرية صغيرة يعرف أفرادها بعضهم بعضا.
إن القفزات التكنولوجية العظيمة التي يشهدها العالم جعلت التواصل بين بني البشر على سطح هذه المعمورة أمراً ميسوراً، وسريعاً، مقارنة بأي زمن مضى، وبكلفه تكاد تكون مجانية. إلا أنه مع كل هذا التطور، مازال الإنسان عرضه للضغوط والتحديات التي تواجهه على كافة المستويات، وخصوصاً على المستوى الإنساني/الثقافي، حيث ظلت أزمة التواصل والحوار مع الذات، ومع الآخر والمختلف، من أبرز الإشكاليات الحقيقية التي يعانيها ويعيشها هذا الإنسان، ضمن دوائر هوياته المتعددة والمختلفة.
لقد كان مأمولاً أن يساهم هذا التطور التكنلوجي المذهل في تجسير الهوة بين بني البشر، على اختلاف هوياتهم وثقافاتهم وانتماءاتهم، وأن يتخذوها وسيلة للتواصل والتعارف والتآزر والتعاون، وأن تتحول إلى فرصة للتبادل الثقافي والمعرفي، ووسيلة إثراء إنساني.
إلا أنه خلافاً لما هو مأمول حوّل البعض هذا التطور إلى وسيلة للكراهية والتنافر وصراع الهُويات، وبث الفرقة والشقاق، وإذكاء روح التعصب، والانغلاق على الذات، وتعبئتها ضد الآخرين، ممن لا ينتسبون إلى هويتهم، أو نمط تفكيرهم، سواء كانوا من الأبعدين، أو من الأقربين الذين ينتمون وأياهم إلى مجتمع واحد.
وأمام هذا التحدي الذي تعيشه النفس البشرية، ظلت الكلمة الطيبة تعاني من حالة اغتراب حقيقية، نتيجة رسوخ حالة الانغلاق والتقوقع والانكفاء على الذات، والشعور بالتعالي والاكتفاء الذاتي، بسبب ضعف ثقافة الحوار وآداب التخاطب، التي تعزز روح الانفتاح والمحاكاة مع النسيج الإنساني المختلف، والانسجام مع ما يقتضيه قانون التنوع والتعدد البشري والإنساني، حيث للكلمة الطيبة دورها الساحر والمبدع في ترسيخ علاقات الود الإنساني، والتعاطف بين بني البشر، بعيداً عن كل أشكال لغة الفظاظة والغلاظة وعنف الكلمة، وبعيداً عن كل الأشكال النمطية والرتيبة والبليدة في الحوار والتخاطب.
إن أزمة التواصل بين بني البشر ليست إشكالية طارئة نشأت مع بدايات الثورة التقنية، بل هي أمر تاريخي قديم بدأت مع رحلة الإنسان في هذه الحياة، حيث ”احتلت قضية الصراع الديني مكان الصدارة في تاريخ صراع الجنس البشري، إذ لم يخل عصر من العصور من وجود خصومة بين الشعوب على أساس ديني، تصل في كثير من الأحيان إلى حد الصراع المسلح بينها. كذلك لا يلتقي اثنان من أتباع دينين مختلفين إلا وتقوم بينهما مناقشات ومحاورات حول مبادئ وتعاليم عقيدتيهما، تارة تكون بألفاظ مهذبه، وأخرى تصل إلى حد التراشق بالألفاظ الخارجة عن موضوع البحث، أو باسلوب يتسم بالعنف والبعد عن الطريق الموصلة إلى الحقيقة“. [1]
إننا اليوم مع الأسف الشديد، دائماً ما نجد أن الصيغ الحوارية التي تحكمها مفردات التخاطب الأخلاقي، التي تتضمن معاني الاحترام والحب والتكريم، والتي تخترق القلوب، وتُعمِّق الحقيقة، وتضيق الهوة والخلاف بين الناس، قد أصبحت غريبة، ونادراً ما تجري على الألسن، أو يتم النطق بها وتداولها على مستوى التخاطب والحوار والتواصل بين بني البشر، بسبب الحواجز العصبية والنفسية التي يضعها الناس أمام بعضهم البعض.
فكم هم هؤلاء الذين إذا تكلموا وتحدثوا أثاروا بكلامهم المشاكل والضغائن والفتن، لأن السنتهم اعتادت وتعوَّدت على استخدام الكلمات غير المؤدبة في التخاطب، فهم لا يحسنون لغة الحديث، ولا استعمال الكلمات والمفردات والجمل والتعابير اللائقة والمناسبة. فهم دائماً ما يعتمدون، وربما يتعمَّدون في بعض الأحيان، في تخاطبهم مع الآخرين، لغة فجه فوضوية ومستفزه ومهينه وجارحة وعنيفة، معتقدين أنهم يحسنون لغة الحديث وصُنعه الّلغة، لكنهم ويا للأسف الشديد، لا يعون أو يدركون أن لغتهم هذه تفتعل التوتر، وتؤجج المشاعر، وتثير السخط، وتشيع الفتنة، وتُفشي روح الفرقة والتنازع، وتضعف الصلة مع الآخر، وتؤدي إلى الخصام والقطيعة معه.