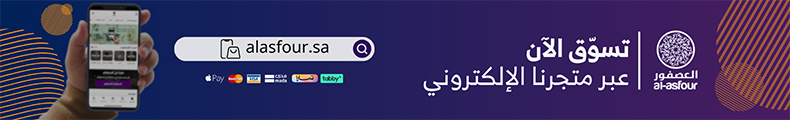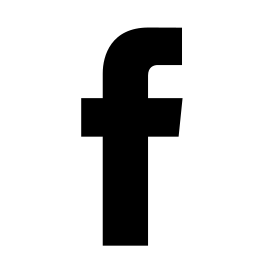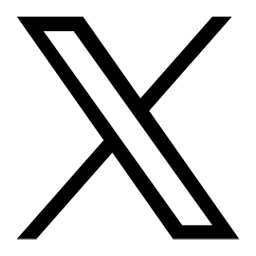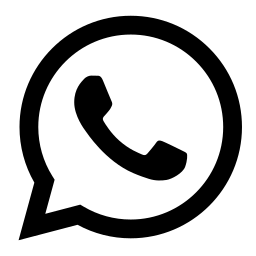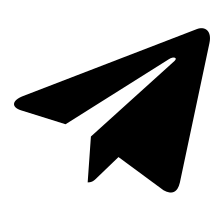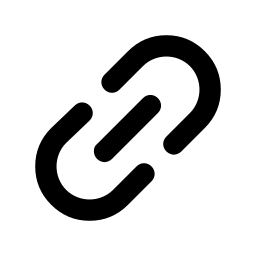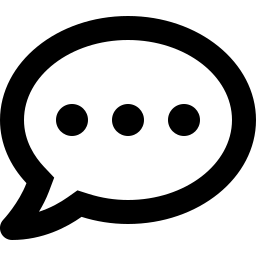نعم لتقديس الأشخاص
بداية أود التفريق بين تقديس النص وتقديس الآراء وتقديس الأشخاص.
فقديما كانت العرب معروفة بالجفاف في التعامل مع بعضهم، وأكثر عنصرية من بقية الأعراق الأخرى، لقد وثق القرآن الكريم كما السنة النبوية صورا من الصلف والقسوة في التعامل معه ﷺ. أما في الشرق كالصين والهند وبلاد فارس، فالثقافة هناك مختلفة، فالسيد أو الحاكم أو حتى رب العمل، كل هؤلاء لهم تعظيم كبير وحالة من القداسة عند التعامل معهم من قبل من هو دونهم. وآثار هذا التقديس مازالت باقية سارية حتى الآن في مفاصل عديدة من حياتهم.
يذهب أصحاب دعوات التحذير من تقديس الأشخاص باعتباره ظاهرة موجودة تجتاح المجتمع، وأيضا باعتباره عمل يشل التفكير الحر، بل يلغي شخصية الفرد ليكون منقاد للشخص «دون تحديد» الذي يقدسه وينساق لكل ما يقوله أو يفعله.
عملياً، نرى أن المناداة بعدم تقديس الأشخاص هي في أحسن حالاتها دعوة لعدم الارتهان والتسليم بالأفكار الصادرة ممن نسميهم رجال الدين فقط، وأن كان لا يقبل - نظريًا - دعاة عدم التقديس بهذا التفقيط، ولكن الواقع العملي يقول شيء مختلف.
من أهم المآخذ على هذه الدعوات هي انتقالها من مواجهة افكار ومقولات هؤلاء - كما تزعم هذه الدعوات - إلى الوقوع في فخ محاربة الأشخاص أنفسهم «رجال الدين» ومن في حكمهم ومن يتوقع أنه يتبع أو حتى يميل إلى أفكارهم، وللمقارنة لنا أن نتخيل - فقط تخيل - هل هناك من يجرؤ على توجيه مثل هذه الدعوات أو الاتهامات إلى فقهاء القانون والمحامين بالرغم من حالة التشابه بينهما؟ لن اسهب أو أحرف الموضوع لتبيان أوجه الشبه ولكن أدعو فقط للتأمل فيه.
نحن لا نتحدث عن متلازمة استوكهولم أو حتى الدفاع أو مكافحة الكراهية تجاه «رجال الدين»، بل فقط عن الفعل في معناه نفسه تجاه حالة تحتاج معالجة عاجلة ودائمة لسلامة الفطرة الاجتماعية، مقابل هذا الكم وهذا الافراط - بلا ضابط - في الدعوة لعدم تقديس الأشخاص، فهي لا تكاد تفرق بين تقديس النص وبين تقديس الأشخاص أو تقديس الأراء.
لقد توسعت هذه الدعوات وزادت عن الإطار العلمي إلى أن أخذت تصرخ في أوساط الناس وهي في الأصل موجهة لهم، وكأننا نعيش حالة من عبودية الأشخاص لبعضهم والعياذ بالله، أو كأن هذه التهمة انتشرت لتصبح مثل التحية بين الناس العاديين.
أن التعامل باعتبار تقديس الأشخاص تهمة قد ترقى لعبادة الأشخاص، هو شبيه بممارسة البعض لتحطيم الآثار التاريخية بذريعة أن هناك من يقوم أو قد يقوم بعبادتها، فلا المتهمون يقبلون بالتهمة ولا التكييف الواقعي والمنطقي يدعمها.
المثال الآخر لهذا النوع من الاتهام هو ما نراه حاليًا من اتهام لبعض المراهقين - ومن في حكمهم - بتهمة الإلحاد والعياذ بالله، فهل يمكن تكييف مثل هذا الاتهام على شاب ولد في بيئة مسلمة ومن ابويين مسلمين وهو لم يبلغ العشرين من العمر، وأنه استطاع فك القيد الثقافي وقطع كل المدى الفكري والثقافي ليصل لقناعة بالالحاد وهو بهذا العمر الغض!!..
عندما ننظر للعالم اليوم، لا نجد هذه الحالة من فوبيا تقديس الأشخاص، بل العكس هو الصحيح، هناك الدعوات والممارسة أيضا لتقديس الأشخاص لأنهم بشر أولاً وقبل كل شيء، ثم بما يحسنون صنعه للإنسان مهما قل هذا الصنيع، دون أي تحفظ أو هواجس من هكذا اتهام.
ولترجمة وتقريب هذا المعنى يمكننا أن نقول اننا نحتاج لنتعامل مع بعضنا ومع الآخرين وكأنهم كلهم بمراتب وظيفية عليا أو كما نعامل الوزير - كمثال -، وما المانع وما المحذور في ذلك؟
باعتقادي أنه لا يوجد أي محذور سوى ما اعتدنا عليه من حالة التصغير لبعضنا البعض، صغرنا بعضنا في كل شيء حتى وصلنا لنبز وتصغير ألقاب عائلاتنا - والأمثلة حية وكثيرة -، وهي أصبحت موروث وعادة نتوارثها كابرًا عن كابر دون غضاضة أو استحياء.
كل الشعوب المتطورة التي نراها اليوم متطورة، كانت بداياتها بسيطة، عفوية احيانا ومضحكة احيانا أخرى، ونحن نكثر الحديث عن تطور هذه الشعوب ونثني عليها وعلى تقدمهم، بل ونبالغ احيانا كثيرة في ذلك كما نبالغ في جلد أنفسنا، ولكن ما أن تظهر لنا بوادر وبراعم أو حتى فيروسات للتطور يمكن البناء عليها، حتى نتفنن في وأدها وأدًا وبألاسلحة الفتاكة، ولسان حالنا يقول: نريد مخالفة كل سنن التقدم، ولا نريد التطور والتقدم الا دفعة واحدة كشربة ماء.
لا نريد الاستمرار في التفنن في تصنيع وإشاعة حالة القلق في المجتمع، واستخدام سطحية خطاب الفانشيستا كخطاب فكري تارة وإعلامي تارة أخرى.
بعض هذا التعاطي يحمل من الأخطاء أكثر من الأخطاء التي تحملها الترجمة عبر مواقع الإنترنت المختلفة.
لعلنا نحتاج أن نصل في التعامل مع مروجي حالة القلق في المجتمع مثل التعامل مع المؤلفة قلوبهم للحد من هذا النوع من الحدة والتعميم في الخطاب مع المجتمع ومع شرائح مهمة منه، وفي حالات غريبة أصبحنا نحمل الأفراد في المجتمع مسؤولية الأخطاء التي ترتكبها المؤسسات والكيانات ذات الشخصية الاعتبارية!.
وهنا حسبنا أن ننتظر برامج الذكاء الاصطناعي القادمة التي ستتعلم وتحتوي تلقائيَا وبذكاء أرقى كل ممارساتنا، حيث ستفضح بعدها جميع هذه الأنماط المتناقضة التي نعيشها، وهذا مجال واسع يمكن الاطلاع عليه من خلال المقالات المتخصصة في هذا المجال.
أن التقنية وبالرغم من حالة المنافسة مع الإنسان، وبعد التوسع في مجالات استخداماتها الا انها أثبتت عمليا أيضا حاجتنا الإنسانية لتقديس الإنسان، فالمخاوف والقلق الآن يتزايد من القدرة على التعامل مع الأشياء بالاعتماد على التقنية فقط، دون الحاجة للتعامل مع الإنسان، بعد أن كان هذا الأمر مطلباً في مرحلة سابقة.
أن مخاطر حالة تقديس الشخوص - إذا كانت هناك مخاطر - فهي حتما ستكون أقل ضررًا من حالة تشويه أو إزالة حالة القداسة عن الأشخاص أو مجرد البقاء على حالة الخوف من تقديس الأشخاص.
الوالدان والمعلم والجار والناس العاديين الذين يخرج من بينهم العلماء باختلافهم، كلها نماذج تعزز الحاجة لتقديس الأشخاص وإشاعة ذلك بلا تحفظ - وليس فقط احترامهم، فهذا مصطلح دبلوماسي لا معنى له - ليس على قاعدة أو خشية من ”فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ“ فقط، وإنما لأنها الوسيلة الطبيعية للحياة المجتمعية السلمية والاساس للتطور ودفع الناس بعضهم بعض للخير ”وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ“.
هل يمكن افتراض - مجرد افتراض - أن المستهتر والمتهور في قيادة سيارته الذي يعرّض حياة الناس للمخاطر يمكن أن يكون أو يناسبه أويناسب أن نصفه أنه يقدس الأشخاص بغض النظر عما هو عليه من سلوكيات أخرى؟ إلا يحتاج مثل هذا لعملية جراحية عاجلة لزرع قدسية الإنسان في قلبه وعقله؟
نحتاج أن يكون التقديس للأشخاص في عقلنا الباطن وسلوكنا العام كي لا يتأثر باي انتقاد أو عدم قبول لبعض الأفكار أو الأشخاص قد نختلف حولها.
وإذا كان هذا المطلب ثقيلاً على النفس، فليكن في الحد الأدنى التوقف عن إشاعة حالة القلق بين الناس عبر تصنيع تهمة تقديس الأشخاص.