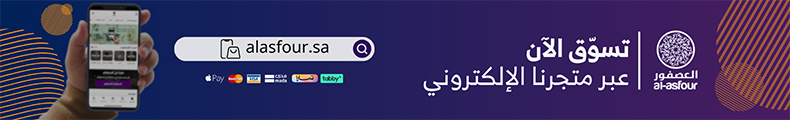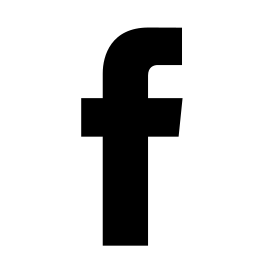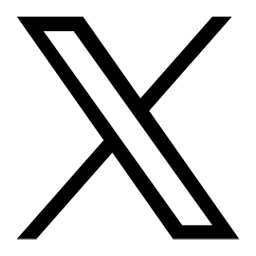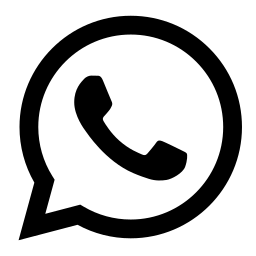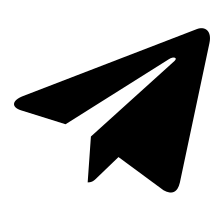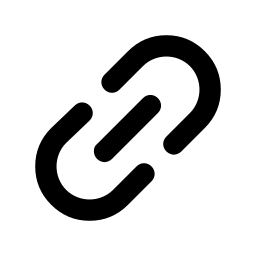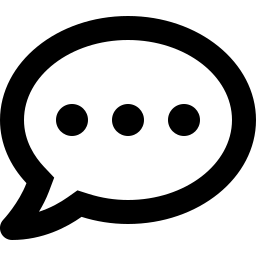لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ؟
لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ * فَلَا يُغَرَّ بِطِيبِ العَيْشِ إِنْسَانُ
هذا هو البيت الأول من قصيدة أبي الطيِّب الرنديّ الشهيرة في رثاء الأندلس والتي أنشدها بالمغرب عام 665 هـ عندما تنازل ابن الأحمر الكبير للنصارى عن عدد من القلاع والحصون والأسوار كما جاء في كتاب ”الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية“ لابن أبي زرع الفاسي.
لن أخوض في تحليل القصيدة، ولا حتى في تقييمها، ولا في قضية توفيق الشاعر أو إخفاقه في تحقيق أهدافه من وراء هذه القصيدة من استصراخ الحكام المسلمين لإنقاذ إخوانهم في الإسلام الذين وقعوا في يد نصارى أسبانيا أثناء حركة الاسترداد المسيحية في الغرب، فلذلك أهله. والحقيقة أن هذه القصيدة أُشْبعت شرحاً وتحليلاً ومدحاً وقدحاً. ولكن، استوقفني رأي لعمر محمد عبدالواحد جاء في مجلة جذور في عددها الخمسين أغسطس 2018، حينما قال، ”ابتدأ الشاعر قصيدته بالحكمة القائلة «لٍكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ» ولمثل هذا الابتداء دلالات متعددة منها، أنه لا يمكن أن يبدأ بقول لا يكون متفقاً عليه من الجميع، ويعني ذلك أن هذه الحكمة التي ساقها في مطلع القصيدة حكمة شائعة ويمكن أن تلقى قبولاً واسعاً من الناس.“ ص 127.
ثم بعد ذلك يتساءل، ”ولكن هل هذه الحكمة صحيحة على إطلاقها؟“ ليجيب هو بنفسه على ذلك بقوله، ”ذلك ما لا نقطع به إلا داخل الثقافة العربية التي تؤمن بأن الشيئ إذا اكتمل آل إلى النقصان وبالتالي إلى الزوال“. فللثقافة العربية خصوصيتها التي تنفردبها عن ثقافات أخرى والتي، وهذا ما يهمني هنا، يجعل لها خصوصية في نمط وطريقة التفكير التي يكون تشكُّلها انعكاساً ومرآةً لتلك الثقافة. ولست هنا في صدد تقييم أو تقويم ثقافتنا وطريقة تفكيرنا، وإنما أردت الإشارة إلى خصوصية ثقافتنا كي ندرك جيداً أن لنا خصوصية أيضا في طريقة تفكيرنا وتعاطينا مع الأمور المختلفة من دينية ودنيوية. ولاشك أن تلك الطريقة وتلك الخصوصية لا نستطيع أن نفرضها على الآخرين ولا نستطيع أن نجزم أيضا بأنها هي الطريقة الوحيدة الصحيحة الصائبة، ولا حتى بأنها ”الأقرب“ إلى الصحة والصواب وذلك لأننا لا نمتلك ولا نستأثر بالصواب والحقيقة.
ثم يستطرد في شرح هذه الخصوصية وتأكيدها بقوله، ”إن هذه الحكمة لا تؤمن بها سوى الشعوب القمرية، أي التي تؤرخ لحياتها اعتمادا على دورة القمر، الذي يبدأ صغيراً هلالاً، ثم يتدرج إلى الاكتمال فيصير بدراً، وبعد هذا الاكتمال يتدرج في الصغر، حتى يصير إلى الانمحاق، وبالتالي إلى الزوال. وقد ذكرت كتب التفاسير للقرآن الكريم أنه عندما تنزل قوله تعالى، ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ بكى أكابر الصحابة، وعندما سئِل أحدهم عما يبكيه، أجاب من خلال دموعه،“ كنا في زيادة من أمر ديننا، أما وقد صرنا إلى الكمال، فإنه ليس بعد الكمال إلا النقصان ”ويتفق هذا مع ما تؤمن به الشعوب القمرية من دورات الزمن، فالزمن يسير على هيئة دورات، كل دورة مستقلة عن سابقتها“. ولعل هذا ما نلاحظه عندما يتسنم مدير أو مسؤول عربي زمام الأمور خلفاً للذي قبله. فهذا المدير أو المسؤول الجديد يبدأ
، عادة، من ”نقطة الصفر“ ويستبدل كل أو أغلب الطاقم القيادي الذي نصبه المدير أو المسؤول السابق. فهو لا يريد أن ”يكمل المسيرة“ ولا أن يبدأ من حيث انتهى سلفه. وهذا ما يؤكده عمر عبدالواحد بقوله، ”ولكن هذا التفسير للتاريخ الذي قدمه أبو الطيب الرنديّ في قصيدته، لا يلقى قبولاً او رواجاً، إلا لمن يندرجون في إطار ثقافته القمرية، ربما هناك شعوب كثيرة لا تقبل مثل هذا التفسير للتاريخ، لأنها لا تعتمد على دورة القمر في حساب الشهور والسنين، ولها ثقافتها المغايرة، التي ربما يقبل خلالها القول بأنه ليس بعد الكمال إلا المزيد ومن الاكتمال، فالتاريخ بعد خروج الإنسان من العصور الدينية «العصور التي كانت فيها الرسل والأنبياء» لم يسير في شكل دورات مغلقة مستقلة وإنما يأخذ سيراً خطياً متناميا إلى الأمام Linear.“
فمنطق ”ما بعد الحياة إلا الموت“ سيطر على تفكير بعضنا وشكَّل طريقته في التعاطي مع الأمور وربما جعله يتخاذل عن القيام بدوره في الحياة من إعمار للأرض وخدمة للبشرية، لأن الموت والاندثار والغياب هو النهاية المحتومة الذي تتحطم على يديه الأحلام والآمال. فموت ”الرسول“ أمات معه ”الرسالة“، عملياً وواقعياً، كما يرى. ولعل هذا ما نستوحيه مما جاء في القرآن، ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾. أما المنطق الآخر الذي يرى بأن هذي ”الحياة“ ما هي إلا مرحلة مكملة لمراحل أخرى سبقتها ولبنة لمراحل أخرى ستأتي بعدها لتبني فوقها، وأنه بعد هذه ”الحياة الدنيا“ أو ”الحياة الأولى“ ستأتي ”حياة عليا“ أو ”حياة ثانية“ استكمالاً لسابقتها، فهو، هذا المنطق، غائب تماماً عن الكثير ممن ينتمي لثقافتنا.
وسأترك لكم حساب ”الإيجابيات“ و”السلبيات“ التي اختزنتها ثقافتنا في هذا الخصوص. بل وسأترك لكم ”ابتكار“ أو ”اكتشاف“ الطريقة المثلى لـ ”تقويم“ ثقافتنا كي ”تتكامل“ و”تتلاقح“ مع الثقافات الأخرى التي تأخذ بيدها نحو الكمال!