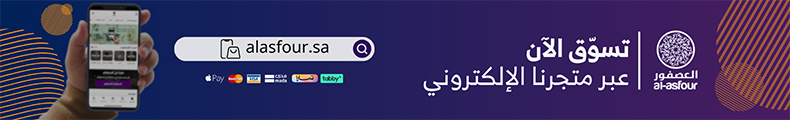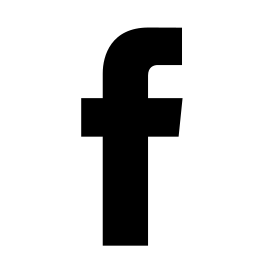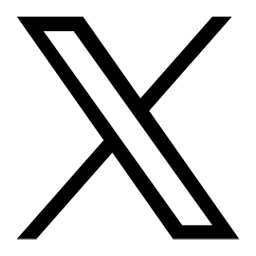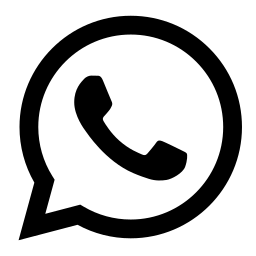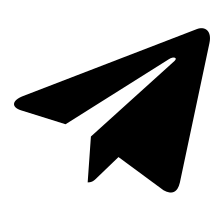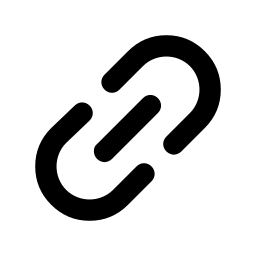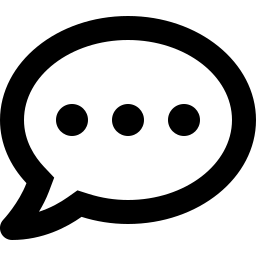«المحبة والسلام في زمن الوباء»
الداء والدواء في زمن الوباء
في ظل المعترك الذي تتسارع أحداثه، وتتتابع إلى حدٍ تغيب معه العقول، فتُصيب الناس حالةً من فقد الاتزان وضبابية الرؤية، واللَهَثَ خلف كلِّ صرخة، يجد الإنسان نفسه في حاجة ماسة إلى خلوة تأمل ووقفة تفكُّر؛ لعله يظفر بلحظة صدقٍ يَمُنُّ الله تعالى فيها عليه بتبصرة وإشراقة.
قد يظن القارئ العزيز أنني سأكتب عن وباء فايروس «كورونا»، وعن اجتياحه للعالم كله.. كلا.. بل أُريد أن أبتعد بكم قليلاً أحبتي؛ لأننا كعرب وكمسلمين، عشنا اجتياحات مذهبية وطائفية شديدة في تاريخنا الفكري والمذهبي طيلة قرون طويلة، هي أشد علينا من أي اجتياح آخر.. وللأسف من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بتكراره.
وربما بعض المهووسين - من رجال الدين وغيرهم - بفكرة نهاية العالم، يطبق هذه الفكرة على ما نعيشه من وباء الآن، مع أنّ تاريخ الأرض الطويل جدًا عرفت جملة من الإنقراضات، التي حصلت بسبب التنافس بين الثدييات أو الأوبئة، أو بحسب بعض الفرضيات العلمية الأخرى، فكل أحداث وأشكال الانقراضات التي حدثت، ووقعت لكائنات حية كانت تعيش فوق البر أو بالبحر، مما يوحي بأنَّ ثمة حادثًا عرضيًا قد وقع وأثَّر على البيئة العالمية، وهذا ليس واقعًا ملموسًا في الوباء الذي نعيشه الآن.
وعند الابتعاد عن الضجيج، والمراء واللجاجة والخصومات، يجد المتأمل أنَّ مسارات كوارث منطقتنا تتلخص في الأمراض التالية:
1. الطائفية: «سنة شيعة إباضية سلفية / مسلمون مسيحيون / عرب كرد أمازيغ... وغيرها».
وجذورها في تاريخنا تعود إلى ما أسماه رسول الله ﷺ ب ”داء الأمم“.. فنلاحظ لماذا لم يقل الرسول ﷺ ”داء الأفراد“، أو لم يقل ”الداء“ مطلقًا وسكت!!. حيث أراد النبي الكريم ﷺ أن يبيِّن أنَّ مصيبة الأمم وتفرق جمعها وزوال أثرها إنما هو بهذا الداء..
وإذا زالت الأمة فأين سيكون موقع الأفراد؟!
إنَّ الفرد بلا جماعة إنما هو ”كالشاة الضعيفة المستسلمة بين أيدي الذئاب، تنهشها وتمزقها، ولا يحق لها سوى صراخ الألم؛ لذا كان التنبيه على أنَّ الداء الذي بدأ يدبُّ إنما هو داء يفتك بالأمة ومن فيها“..
ولنا أن نُقرَّ أنَّ ثقافة ”خير القرون قرني“ تنظر إلى سيرورة التاريخ باتجاه معاكس، ولذلك نحن أمة عصية على التغيير؛ إذ تعتبر أنَّ السلف أكفأ من الخلف بكل نواحي الحياة، فإذا بقينا على ما نحن عليه، سنصبح خارج التاريخ دائمًا، إن لم نكن خارجه بعد.
يقول الإمام علي بن أبي طالب  ، قال: قال رسول الله ﷺ ذات يوم لأصحابه: ”أَلَا إنَّه قَدّ دبَّ إِلَيكُمْ داءُ الأُمَمِ مِنْ قَبلِكُم، وَهُوَ الحَسَدُ، لَيْسَ بِحَالِقِ الشعر، لكنه حَالِقُ الدِّين“ «مسائل علي بن جعفر: ص 337 حديث 830؛ عيون أخبار الرضا: ج 1 ص 279 حديث 83؛ معاني الأخبار: ص 367».
، قال: قال رسول الله ﷺ ذات يوم لأصحابه: ”أَلَا إنَّه قَدّ دبَّ إِلَيكُمْ داءُ الأُمَمِ مِنْ قَبلِكُم، وَهُوَ الحَسَدُ، لَيْسَ بِحَالِقِ الشعر، لكنه حَالِقُ الدِّين“ «مسائل علي بن جعفر: ص 337 حديث 830؛ عيون أخبار الرضا: ج 1 ص 279 حديث 83؛ معاني الأخبار: ص 367».
وفي رواية: ”دبَّ إِلَيكُمْ داءُ الأُمَمِ الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ هيَ الحَالِقَةُ لا أقُولُ تَحلِقُ الشّعَرَ ولَكِنْ تَحلِقُ الدّينَ“ «سنن الترمذي: ج 4 ص 664 حديث 2510».
وهذه استعارة. فالمراد بالحالقة ”الخصلة التي من شأنها أن تحلق، أي تهلك وتستأصل الدين كما تستأصل الموسى الشعر، أي في تباغض بعضهم بعضًا هلاك دينهم وفساده“ «شرح أصول الكافي: ج 9 ص 414».
وعلاجها: إنما يكون بنشر السلام والمحبة كما في تكملة الحديث: ”والَّذِي نَفسِي بيده، لا تَدخُلُوا الجَنَّةَ حتى تُؤمِنُوا، ولا تُؤمِنُوا حتى تحَابُّوا، أفَلَا أُنبِّئُكُمْ بِما يُثبِّتُ ذاكُمْ لكُمْ؟ أَفشُوا السّلَامَ بَينَكُمْ“ «سنن الترمذي: ج 4 ص 664 حديث 2510؛ مسند أحمد: ج 1 ص 164 حديث 1412؛ مسند زيد بن علي: ص 390؛ مستدرك الوسائل: ج 8 ص 362 حديث 9675؛ مشكاة الأنوار: ص 157 حديث 393؛ جامع أحاديث الشيعة: ج 15 ص 592 حديث 1945».
وليس المراد من إفشاء السلام أن تقول «السلام عليكم»، بل هو بديل عما يعرف اليوم ب ”اللاعنف“، ففي طيف اللاعنف امتدادًا لمشاعر الحب في القلب، وبسمة في الوجه، وجمالاً في التعبير، فيكون صاحبها حنانًا من لدن الخبير وكان تقيًا، وصولاً بالطبع إلى التخلص من مفاهيم القوة وعبودية السلاح ومبدأ الإكراه، ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ الصافات: 95 - 96.
إنَّ اللاعنف منظومة لنبذ الحرب ودفع مضاره، وإتباع سياسة السلم مع البشرية كلها، ضمن رؤية القرآن الكريم:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ البقرة: 208.
﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ النساء: 94.
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾ الأنفال: 61.
﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ النساء: 90.
وإنَّ خطًأ واحدًا ك «احتقار الذات» و«الغرور» و«الكسل» و«الفوضى» و«عتمة الرؤية» أو «الكره» يمكن أن تصيب فاعلية المرء والمجتمع بالشلل التام.. وبالعلم والحب والتفاؤل تنهض الأمم، فأقوى الأمم هي أكثرها علمًا ومحبة. فالعلم حاكم لأنه يسيطر على حركة الحياة، ويعطي الحياة حيويتها، ويرفع مستوى الإنسان، فالحياة من دون علم موت وجمود.
2. العنصرية: «عربي وفارسي وكردي وأمازيغي ونوبي، هاشمي وقحطاني، نجدي وحجازي ويماني، بدوي وحضري، أسود وأبيض.. الخ».
وجذورها تعود إلى ما أسماه النبي الكريم ﷺ: ”دعوى الجاهلية“. ففي عهده ﷺ قامت فتنة بين المهاجرين والأنصار، فنادى كلُّ طرفٍ قومَه ”يا للمهاجرين، يا للأنصار“.. وتكرر المشهد - أيضًا - بين قبيلتي الأوس والخزرج من الأنصار، فنادى كل طرف قبيلته: ”يا للأوس، يا للخزرج“.
فقال النبي ﷺ: ”يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أبدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأنَا بَيْنَ أظْهُرِكم بَعْدَ إذْ أكْرَمَكُمُ اللهُ بالإسْلاَمِ وقَطَعَ بِهِ عَنْكُمْ أمْرَ الجَاهِلِيَّةِ، وَألَّفَ بَيْنَكُمْ، فَتَرْجِعُونَ إلَى مَا كُنْتُمْ كُفَّاراً؟ اللهَ الله“ «اللباب في علوم الكتاب: ج 5 ص 425».
وفي رواية: قال ﷺ: ”دَعوهَا فَإنَّهَا منْتِنَةٌ“ «صحيح البخاري: ج 4 ص 1863 حديث 4624؛ صحيح مسلم: ج 4 ص 1998 حديث 2584».
وفي رواية: فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاكَ، فَقَالَ: ”مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ“؟! فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: ”دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ“ «صحيح ابن حبان: ج 13 ص 330 حديث 5990».
وعلاجها: اعتبار التقوى ميزان المفاضلة كما قال رسول الله ﷺ: ”لاَ فضْلَ لعربي على أعجمي ولاَ لعجمي على عربي ولاَ لأحْمَرَ على أسْوَدَ ولاَ أسْوَدَ على أحْمَرَ إلاَّ بِالتّقْوَى“ «مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 411 حديث 23536».
وعن الإمام محمد الباقر  قال: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: ”أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَفَاخُرَهَا بِآبَائِهَا، أَلا إِنَّكُمْ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ طِينٍ، أَلا إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ عَبْدٌ اتَّقَاهُ، إِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ بِأَبٍ وَالِدٍ وَلَكِنَّهَا لِسَانٌ نَاطِقٌ، فَمَنْ قَصَرَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُبْلِغْهُ حَسَبُهُ، أَلا إِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ إِحْنَةٍ «وَالإِحْنَةُ الشَّحْنَاءُ» فَهِيَ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ «الكافي: ج 8 ص 246».
قال: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: ”أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَفَاخُرَهَا بِآبَائِهَا، أَلا إِنَّكُمْ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ طِينٍ، أَلا إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ عَبْدٌ اتَّقَاهُ، إِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ بِأَبٍ وَالِدٍ وَلَكِنَّهَا لِسَانٌ نَاطِقٌ، فَمَنْ قَصَرَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُبْلِغْهُ حَسَبُهُ، أَلا إِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ إِحْنَةٍ «وَالإِحْنَةُ الشَّحْنَاءُ» فَهِيَ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ «الكافي: ج 8 ص 246».
وقد وضع القرآن كل ذلك في ضمن منظومة رائعة:
أ. الإسلام هو دين الإنسانية، وهو الدين القيّم بكونه يشمل كل من آمن بالله وعمل صالحًا ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ الكهف: 110.
ب. العمل الصالح هو كل ما يساهم في تقدم الإنسانية نحو الأفضل، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ آل عمران 85.
ت. استخلفنا الله على هذه الأرض وتحدى بنا باقي الكائنات لا ليعذبنا، بل يريد لنا كل الخير ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: 30.
ث. من عمل خيرًا سينال جزاءه ومن عمل شرًا سينال جزاءه، وإذ وضع الله لنا محرمات محدودة وترك للشرائع الإنسانية تقرير الأفضل وفق ما يناسبها في المكان والزمان، جعل من الإسلام مظلة يمكن أن تضم تحتها معظم أهل الأرض، توحدهم الإنسانية بغض النظر عن كيفية ممارستهم لشعائرهم كأفراد، فالعلاقة مع الله شأن خاص بكل إنسان، وبيد الله وحده محاسبته عليها في اليوم الآخر ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ الحج: 17. وهذا مثال على اعتراف القرآن بالتعددية.
وللأسف أقولها: مع كل جهوزية الرسول محمد ﷺ، وطاقته للقضاء على عصبية الدين والنسب؛ حيث قال: ”مَن كانَ في قَلبِهِ ذرَّةٌ مِن حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ مِن عَصبِيَّةٍ بَعثَه اللهُ يومَ القِيَامةِ مع أعرَابِ الجَاهِليَّةِ“ لكنَّ هذه الأمة لم تأخذ بهذه النصائح النبوية، فلم تساعد نفسها أن تكون أمة مدنية أساسها العلم وعدالة القانون.. فكل أمارة بعد الرسول قامت على مشروع عصبي وقبلي.
فبدل أن يكون «الاختلاف» نوعًا من أنواع الثقافات السائدة بين العرب والمسلمين، تحولت إلى عصبية مذهبية بين الأطراف جميعًا. فالعصبية لا تقف أشكالها، في يومنا هذا، في الانتماءات العرقية والقبلية والعائلية، وإنما - أيضًا - دخلت في مختلف الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والحزبية. فلا شك أنَّ الاختلاف هو صناعة الخلق في الحياة، ولولاه لما تفتحت أبواب الاستكشاف والتطور.
إنَّ العصبية كشعورٍ هو أمر محمود، وقد فطر الله الناس عليه ليملكوا الدافع الذي يدفعهم نحو الفعل أو الترك، وهو أمر تحتاجه الحياة الإنسانية، ولولاه لأصيبت حركة الإنسان بالبرودة والتردد، ولكنها قد تتحول إلى حالة سلبية عندما تتعلق بأمر سلبي، وتنفلت من ضوابط القيم.
وهذا ما يوضحه حديث الإمام علي بن الحسين  - في تعريف العصبية -: ”الْعَصَبِيّةُ الَّتِي يَأْثمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا؛ أن يَرىَ الرَّجُلُ شِرَارَ قَوْمِهِ خَيْرًا مِنْ خِيَارِ قَوْمٍ آخرِين. وَلَيْسَ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أن يُحِبَّ الرَّجُلُ قُوْمَهُ، وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيّةِ أنْ يُعِينَ قُوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ“؛ بحيث يُصبح الشرير الذي ينتمي إلى جماعتي أفضل من الخيِّر الذي ينتمي للجماعة الأخرى، فقط؛ لأنّ الأول يشاركني الانتماء، والثاني لا يشاركنيه، فليست المسألة مسألة خيرٍ وشر، بل مسألة إطار وانتماء.
- في تعريف العصبية -: ”الْعَصَبِيّةُ الَّتِي يَأْثمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا؛ أن يَرىَ الرَّجُلُ شِرَارَ قَوْمِهِ خَيْرًا مِنْ خِيَارِ قَوْمٍ آخرِين. وَلَيْسَ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أن يُحِبَّ الرَّجُلُ قُوْمَهُ، وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيّةِ أنْ يُعِينَ قُوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ“؛ بحيث يُصبح الشرير الذي ينتمي إلى جماعتي أفضل من الخيِّر الذي ينتمي للجماعة الأخرى، فقط؛ لأنّ الأول يشاركني الانتماء، والثاني لا يشاركنيه، فليست المسألة مسألة خيرٍ وشر، بل مسألة إطار وانتماء.
وللأسف، فقد قتلت هذه الأمة نفسها بسبب أوهام الماضي، ولكي تخرج منها تحتاج إلى أن تتوازن لتنظر إلى المستقبل بتفاؤل، فما مضى فقد مضى ف﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
لقد جاء الرسول الكريم ﷺ لرفع الأغلال التي أسرفتها الأمم السابقة على نفسها، فلماذا لم تزل تلك الأغلال تطوق فكر ووعي هذه الأمة، ولماذا لم تمتثل لمنهج رسول الله ﷺ؟!.. كفانا تشددًا.
إننا بحاجة ماسة إلى لقاح هو «العقل»؛ يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق  : ”حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل“..
: ”حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل“..
3. الغثائية أو اللهث خلف الأطماع الدنيوية «المال، السلطة، المغالبة».
قال ﷺ: ”إن الدنيا حلوة خَضِرة، وإن الله مُسْتخْلِفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا..“.
وقال ﷺ: ”.. وإنّي والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها“.
وقال ﷺ: ”.. فوالله لا الفقرَ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم“.
وربما جذورها تعود إلى أحاديث نُقلت على لسان رسول الله ﷺ، تدخل في ضمن الملاحم والفتن!!، وهي: ”الوهن“.. قال رسول الله ﷺ: ”.. وليقذفن الله في قلوبكم الوهْن“. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهْن؟ قال: ”حب الدنيا وكراهية الموت“... والأحاديث في هذا كثيرة جدًا.
والذي ينبغي - قوله هنا - والتحذير منه: إنَّ من أسس الإصلاح الديني ترسيخ قيمة الحياة عند الناس؛ لأنّ رجال الدين خلال قرون نجحوا في إقناع الناس بالنظر إلى الحياة نظرة ازدراء، واستعمل نهاية الحديث ”حب الدنيا وكراهية الموت“ في ترسيخ أنَّ كلَّ إنسان يحب الحياة ويكره الموت عليه أن يشعر بالذنب. فأصبحنا لا نستغرب القتل الجماعي والمجازر كما لو أنها في وجداننا.
نعم، نحن نحب الدنيا من دون إيثار على بقية الأشياء، وقد قال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الأعلى: 16. ”فترفضون التزكية والتطهر والخروج من عبادة المادة إلى عبادة الله تعالى، وتستسلمون للحياة الدنيا في لذّاتها وشهواتها وقيمها المادية القائمة على أنانية الذّات، وثورة الغريزة، وجشع الطمع، والاستعلاء على الناس، والبغي عليهم بغير حق، والإخلاد إلى الأرض في كلِّ إيحاءاتها التي تدفع الإنسان إلى الأسفل، وتمنعه من التطلّع إلى الأعلى في رحاب الله تعالى“ «من وحي القرآن، ط جديدة: ج 20 ص 129»..
ومن كلام الإمام علي بن أبي طالب  ، وقد سمع رجلاً يذم الدنيا: فقال: ”أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا، الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا، الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا! أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمَّ تَذُمُّهَا؟ أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا، أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ؟ مَتَى اسْتَهْوَتْكَ أَمْ مَتى غَرَّتْكَ؟ أَبِمَصَارِعِ آبَائِكَ مِنَ الْبِلَى أَمْ بِمَضَاجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَى؟ كَمْ عَلَّلْتَ بِكَفَّيْكَ، وَكَمْ مَرَّضْتَ بِيَدَيْكَ! تَبْتَغِي لَهُمُ الشِّفَاءَ، وَتَسْتَوْصِفُ لَهُمُ الْأَطِبَّاءَ، غَدَاةَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ دَوَاؤُكَ، وَلاَ يُجْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ. لَمْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاقُكَ، وَلَمْ تُسْعَفْ فِيهِ بِطِلْبَتِكَ، وَلَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّتِكَ! قَدْ مَثَّلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنْيَا نَفْسَكَ وَبِمَصْرَعِهِ مَصْرَعَكَ.. إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا، وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، وَدَارُ غِنىً لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِهَا.. مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللهِ، وَمُصَلَّى مَلاَئِكَةِ اللهِ، وَمَهْبِطُ وَحْيِ اللهِ، وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللهِ، اكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ. فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا وَقَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا وَنَادَتْ بِفِراقِهَا، وَنَعَتْ نَفْسَهَا وَأَهْلَهَا، فَمَثَّلَتْ لَهُمْ بِبَلاَئِهَا الْبَلاَءَ، شَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ؟! رَاحَتْ بِعَافِيَةٍ وَابْتَكَرَتْ بِفَجِيعَةٍ، ترغِيبًا وَتَرْهِيبًا، وَتَخْوِيفًا وَتَحْذِيرًا، فَذَمَّهَا رِجَالٌ غَدَاةَ النَّدَامَةِ، وَحَمِدَهَا آخَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.. ذَكَّرَتْهُمُ الدُّنْيَا فتَذَكَرُوا، وَحَدَّثَتْهُمْ فَصَدَّقُوا، وَوَعَظَتْهُمْ فَاتَّعَظُوا“ «نهج البلاغة: الحكمة 128».
، وقد سمع رجلاً يذم الدنيا: فقال: ”أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا، الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا، الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا! أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمَّ تَذُمُّهَا؟ أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا، أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ؟ مَتَى اسْتَهْوَتْكَ أَمْ مَتى غَرَّتْكَ؟ أَبِمَصَارِعِ آبَائِكَ مِنَ الْبِلَى أَمْ بِمَضَاجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَى؟ كَمْ عَلَّلْتَ بِكَفَّيْكَ، وَكَمْ مَرَّضْتَ بِيَدَيْكَ! تَبْتَغِي لَهُمُ الشِّفَاءَ، وَتَسْتَوْصِفُ لَهُمُ الْأَطِبَّاءَ، غَدَاةَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ دَوَاؤُكَ، وَلاَ يُجْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ. لَمْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاقُكَ، وَلَمْ تُسْعَفْ فِيهِ بِطِلْبَتِكَ، وَلَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّتِكَ! قَدْ مَثَّلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنْيَا نَفْسَكَ وَبِمَصْرَعِهِ مَصْرَعَكَ.. إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا، وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، وَدَارُ غِنىً لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِهَا.. مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللهِ، وَمُصَلَّى مَلاَئِكَةِ اللهِ، وَمَهْبِطُ وَحْيِ اللهِ، وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللهِ، اكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ. فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا وَقَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا وَنَادَتْ بِفِراقِهَا، وَنَعَتْ نَفْسَهَا وَأَهْلَهَا، فَمَثَّلَتْ لَهُمْ بِبَلاَئِهَا الْبَلاَءَ، شَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ؟! رَاحَتْ بِعَافِيَةٍ وَابْتَكَرَتْ بِفَجِيعَةٍ، ترغِيبًا وَتَرْهِيبًا، وَتَخْوِيفًا وَتَحْذِيرًا، فَذَمَّهَا رِجَالٌ غَدَاةَ النَّدَامَةِ، وَحَمِدَهَا آخَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.. ذَكَّرَتْهُمُ الدُّنْيَا فتَذَكَرُوا، وَحَدَّثَتْهُمْ فَصَدَّقُوا، وَوَعَظَتْهُمْ فَاتَّعَظُوا“ «نهج البلاغة: الحكمة 128».
نعم، إنَّ مَنْ يحب الحياة لا بدَّ أن يحب البشر والبيئة التي تتكون منها.
فالمؤمن هو الإنسان المنفتح على الحياة، المحب للدنيا، من دون أن يستسلم لنزواته وشهواته، فهو يعرف قيمة كل الرغبات والمظاهر المادية وما تعنيه، بل يقبل عليها، ولا ينسى نصيبه الطبيعي منها، مع التزام بحدود ما أمر الله، فيوازن بين كل ذلك، ويعيش حرية الذات، وعزة النفس، وقوة الإرادة، وعمق الوعي والحكمة والمسؤولية في كل شؤونه وأوضاعه المادية والمعنوية؛ فهو «إنسان الله»، الخليفة المستخلف في الأرض، يبث فيها كل بر وخير ونفع.
ولذا قال الله تعالى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾؛ وهي دار الدنيا التي نعيشها.. وعليه فإنّ عالم الملك، وهو مظهر الجمال والجلال وحضرة الشهادة المطلقة، ليس مذمومًا بهذا المعنى، بل المذموم هو دنيا الإنسان نفسه، أي التوجه إليها والتعلق بها وحبها، وهذا هو منشأ كل المفاسد والخطايا القلبية والظاهرية.
ملاحظة دقيقة:
إذا لم تكن مؤمنًا بوجودك كإنسان، فإنَّ كل الأخلاقيات والقيم الإنسانية تسقط وتزول من مفاهيم الحياة. وفي الكوارث من النوازل العامة التي تعصف بالمجتمعات والأمم، علينا أن نسأل الله العافية والفرج ومجالها «التزكية».. وإلى هذا المعنى أشار الحق سبحانه وتعالى؛ فقد اهتم بذكر المظاهر المؤثرة في هذا العالم «الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض»، واهتم بعد ذلك بنفس الإنسان وكأنها من مظاهر التأثير في هذا الوجود.
ثم جعل جواب هذا الاهتمام هو أنَّ ”الفلاح“ و”الخيبة“ معلقان على تعامل الإنسان مع نفسه فقال تعالى في سورة الشمس: ﴿قدْ أفلَحَ مَنْ زَكَّاها وقدْ خابَ مَنْ دَسَّاها﴾.
إذن فالحل والعلاج القرآني لهذه الكوارث هو ”تزكية النفوس“؛ وهي تحريك المفاهيم الراقية في عملية التغيير للواقع الداخلي، من أجل أن يكون الإنسان فاعلاً ينمو ويتطور في اتجاه الخير..
وما نحتاج إليه اليوم هو شجاعة مواجهة هذه الحقيقة قبل أن تسارع نفوسنا الأمّارة بالسوء إلى التهرّب من مواجهتها بالاستخفاف بها، ودعوى الاشتغال بالقضايا العامة، والشؤون العظمى للأمة.
والتزكية ليس لأننا ننتمي لدين واحد، ولا لمذهب واحد، ولا للون عرقي واحد، وليس لأننا نتكلم لغة واحدة، فهذا كله لا شأن له بالتزكية.. بل التزكية الحقيقية أن الله خلقنا مختلفين وأمرنا أن نتعايش بالسلام والمحبة والتعاون ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ الحجرات: 13، وإلا لخلقهم سبحانه أمة واحدة وكفى ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ هود: 118.
إذن، "نحن ننشدُّ إلى المحبة كطريق..
وننشدُّ إلى المحبة كهدف..
وثمرة المحبة أنها لا تأتي بالسعادة دائمًا. بل في عمقها تتلاحق الابتلاءات، وبمقدار هذه الابتلاءات تتجذر المحبة في علاقة وحدانية، وجداناً وعقلاً وقانونًا.
فالحب جمال مؤلم لا يراه إلا العاشقون؛ نعشق لونه، ونعشق حرفه، نعشق قربه ولو كان عذابًا.. إنه الحب العظيم الذي يتجلى بصور متعددة.
إنَّ المحبة كنز يفتش عنه كل البشر في هذا الوجود، بل به سينقشع الكنز، وسيتراءى لكل واحد منا تلك الكينونة بأفرعها المتعددة، والمترتبة على طبيعة التصورات أو المفاهيم والقوانين العلمية..
فهل هي: المادة.. الطاقة.. الزمان.. المكان.. الكم.. الكيف.. العلة؟.. أو هي القوانين برمتها في كلِّ هذا الوجود.. أو أنها فوق كلِّ ذلك؟! " «المحبة المغتربة، للكاتب، تحت الطبع».
نعم، "ثمرة المحبة أنها لا تأتي بالسعادة دائمًا..
بل في عمق هذ المحبة تكمن الابتلاءات..
ويكفي أنَّ الابتلاء من أعظم علامات النبوة!!
أن تقف أمام السائد والموروث وتعلن عن نبوتك لله.. أليس هذا بلاء؟!
أن تقف أمام السائد والموروث وتخبرهم عن صفتك من دون حماية كافية.. أليس هذا بلاء؟!
أن تقف أمام السائد والموروث فيؤدِّي بك إلى حصارك محاصرة مضنية في الشعب.. أليس هذا هو البلاء؟!
أن تقف أمام السائد والموروث فيؤدِّي بك إلى هجرتين متتاليتين وغربة.. أليس هذا هو البلاء؟!
أن تقف أمام السائد والموروث فيؤدِّي ذلك لتعقب السذج والشطَّار بالحجارة وإدمائك.. أليس هذا هو البلاء؟!
فهل تستطيع أن تعيش إحساس اللحظة، ومرارته وحرجه؟!
هل تعلمون لماذا تحمَّل النبي محمد ﷺ كلَّ هذه الابتلاءات؟! وكلَّ هذه المحن؟!
لأنه محبٌّ لربه سبحانه.. وبمقدار هذا الابتلاء تتجذر المحبة وجدانًا وعقلاً" «المحبة المغتربة، للكاتب، تحت الطبع».
نسأل الله أن يعمَّ السلام ربوع هذه الأرض، وأن نتعلم درس ما بعد هذا الوباء، وأن نعمِّر أوطاننا ببناء الإنسان أولاً، لا بتطاول البنيان والتباهي بها، فعقول أبنائنا أولى بأن تقدَّر وتحترم، وبعقولهم وسواعدهم نفخر ونعتز.