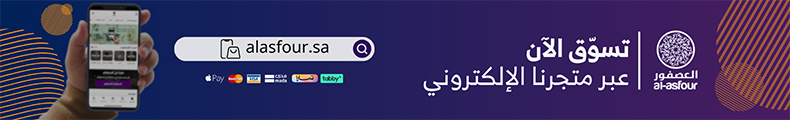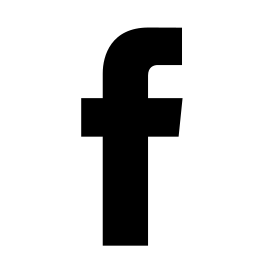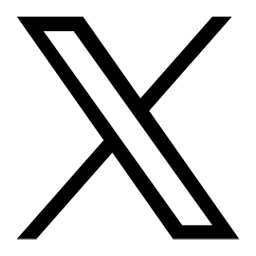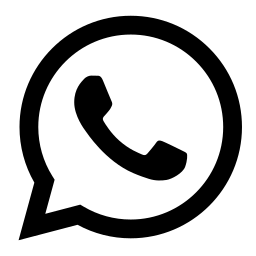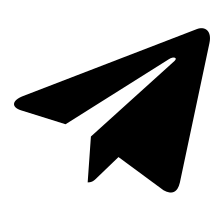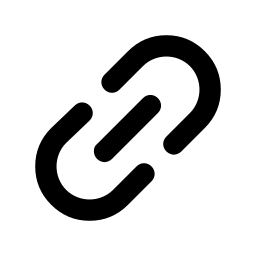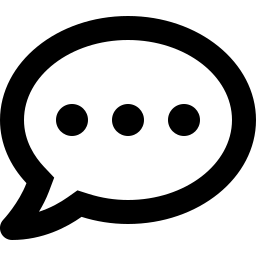تنبؤات درامية أم سينما متواطئة «44»
تباريح صيف، ورسائل طيف، تعبران الأزقة والحواري، وهلال السعد ”ضاوي“، رائحة هيل وبهجة ليل، وتلاوات معطرة تنبعث من المجالس الرمضانية.
أمشي والرفقة محبة بصحبة صديق الصبا، ”علي الحمام“ ندرع سوق تاروت جيئة وذهابا، المقاهي صاخبة بروادها، والدكاكين عامرة بناسها، حراك وسهر ومنقلب ثوري آتية اخباره من الشرق، حديث الناس بحوارات لا تنقطع.
إيه يا عام 79 فأنت آخر الأحلام الوردية وآخر سنين الصفا، وآخر نسمات الزمن الجميل.
على قدر عقولنا الغضة نحاول أن نبحر بأحاديث أعلى من فهمنا، نخوض ثرثرة مع الخائضين، نتفلسف ونتشاطر عما جرى من متغير هز المنطقة هزا، وبينما حديثنا مشتعلا وإذا بأحد أصدقائنا يقطع عنا حبل الكلام، وبابتسامة منه دعانا للركوب في سيارته الجديدة، إنه الصديق ”عبد المهدي الصادق“ صعدنا بفرحة غامرة واقترح علينا أن نذهب معه لسينما ”أرامكو“ وهو المتوظف حديثا في الشركة، وصلنا إلى رأس تنورة ”حي إنترميديت Intermediate - أو حي رضوى - المخصص سكنا للعمال العزاب“ دخلنا صالة السينما الجديدة المكيفة، والذاكرة تحمل شكل السينما القديمة التي كانت مجرد مدرج خشبي وسور بسيط والمشاهدة في الهواء الطلق، كل معالم المكان تغيرت، جلسنا في الصالة الحديثة المكيفة متأخرين بعض الشيء عن بداية الفيلم وإذا بصوت المدافع تصم الآذان، أدخنة وغبار المعارك ونيران مشتعلة تأكل الغابات إنه فيلم حربي عن فيتنام، مناظر الانفجارات تخطف الأبصار، حواسنا مشدودة ونسبة الأدرينالين ارتفعت في عروقنا، تصفيق من بعض الجالسين لبسالة الجندي الأمريكي، وصفير متقطع لفدائية دراما البطل المغوار، وثلاثتنا يعصرنا الأسى لمشاهد البؤس لأناس تباد بشكل همجي، التعاطف يتلون والمشاعر تتباين بين أحداث الفيلم، وثمة مشهد لم يغب عن البال، لقطة لبعض الجنود الأمريكان وهم يعاجلون رجال ”الفوتكونغ“ بطلقات نارية كلمح البصر ويردوهم صرعى على جوانب الدروب الزراعية المتعرجة، أكملوا المهمة وهم فريحين بما أنجزوا وما أن اجتازوا بضعة أمتار وهم مدبرين، بعد دقائق معدودات، وإذا بخروج روؤس وبنادق من جوف الارض، رجال المقاومة متمترسين داخل فوهات صغيرة ممتدة عبر خنادق متشعبة، ومغطاة بأوراق الشجر، حالا أطلق المسلحون الفيتامييون الرصاص سريعا على الجنود الأمريكيين من وراء ظهورهم، وتمت التصفية حالا، إنه كمين محكم، وأسلوب تكتيكي سري أتعب الغزاة ودمرهم تدميرا طوال سنين الحرب، تلك لقطات لدراما فيلم طويل تلاشت بقية مشاهده من الذاكرة.
بعد انتهاء الفيلم سألنا شخصا جاور مقاعدنا في قاعة السينما عن اسم الفيلم، أجابنا بأنه ”فيلم....“ لقد ضاع مني اسمه حاليا نتيجة طول السنين، حاولت أن أشاهد عدة أفلام أثناء كتابة هذه الحلقات لعلني اهتدى لاسم الفيلم، لكن البحث أضناني ولم أعثر على شيء، لأن ميراث الأفلام عن حرب فيتنام تجاوز أكثر من 100فيلم، قليل منها من إنتاج الفيتناميين أنفسهم وبعض الدول والغالبية العظمى لهوليوود وشركات أمريكية أخرى.
بعد أن غادرنا سينما ارامكوا وطوال مشوارنا إلى البلد حديثنا لم ينقطع عن مشاهد الفيلم المروعة، وقد حدثتهم عن فيلم شاهدته صيف 73 حول حرب فيتنام من محطة تلفزيون الكويت، ولقطة للبطل يحاول الهرب عبر نهر الدلتا مع متعاونين فيتناميين فقد اختبأ عن أعين الجنود المرابطين للحراسة فغطس في الماء متشبثا بالمركب النهري من الأسفل، وطوال وقت التفتيش كان يتنفس من خلال قصب البامبو ومر الموقف بسلام ونجا الجندي الأمريكي من الوقوع في الأسر.
خرجنا من السينما وكأننا لم نخرج اللقطات المأساوية للفيلم ماثلة أمامنا، بالنسبة لي ألهب مشاعري وتداخلت أصداء المشاهدة باستذكار أحاديث محمد الصغير المشوقة عن حرب فيتنام قبل سنين خلت، اختلاطات بين ما سمعت عن وقائع معروفة والصورة المغايرة عما شاهدت، دراما الفيلم سيطرت على تفكيري انشغالا لفهم ماهية الحرب أكثر وعن فصول سيناريوهات الكر والفر، فظائع تشبثت في اللاوعي واستحواذ مشاهد الأكشن المنبعثة من حجم شاشة كبيرة وبمؤثرات صوتية مضخمة شدت الأعصاب من رهاب الحرب، ليلتها لم أستطع أن أخلد للنوم إلا بصعوبة بالغة، ومن شدة استحضار وقائع دراما الفيلم أصبت بأرق متقلبا ذات اليمين وذات الشمال، غفوت وأتاني الفيلم حلما، وكأني أتنقل بين أصوات القذائف ورائحة البارود وأدخنة المعارك، خائفا وجلا، وكلما اقترب صوت دقات طبلة ”أحمد المسحر“ بجوار بيتنا أحسبه ضمن إيقاع طبول الحرب، فززت من النوم مستعيذا من الشيطان الرجيم.
تلك الذكرى أتت حضورا أثناء مشاهدتي لفيلم ”القيامة الآن“ خلال أواخر شهر رمضان المنصرم 2020، حضر فيلم الأمس 79 مع مشاهدة فيلم اليوم وكلاهما تزامنا مع الشهر الفضيل، وأيضا ضمن أجواء مرتبطة بأحداث جسام، ذاك ارتبط بمتغير أثر على المنطقة عامة والحالي بزلزال هز العالم من أقصاه إلى أقصاه.
انحياز لا إرادي لمشاهدة فيلم الأمس لأنه الأمتع وله سبق الحضور في الذائقة البكر، أن تكون في كنف قاعة السينما ولأول مرة الأمر مختلف، كنت منبهرا لاتساع المنظر عبر بانوراما الحقول وحراك الجند وكأنني في حضن الطبيعة، رؤية فيلمين حربيين بين زمنين البون بينهما شاسع، متعة الفرجة ماضيا كانت مبهرة، بخلاف المشاهدة الحالية، عبر شاشة صغيرة تفتقد صفة الدهشة، لكن نسبة الفهم حاضرا أوعى وأنضج، واستجلاء النظرتين في علو وهبوط، الفرجة الأولى بحواس مستنفرة والنظرة الحالية متفحصة لما وراء الفيلم وما حوى.
قبل مشاهدتي لفيلم ”القيامة الآن“ قرأته عنه من قبل كثيرا ولم يتسن لي مشاهدته إلا أثناء تدوين هذه الحلقات من خلال شاشة الكمبيوتر، وبينما كنت مندمجا في مشاهدة الفيلم، أتت لي زوجتي وجلست تشاهد معي وهي تتأوه تعجبا، ولم تستحمل إلا ثلث ساعة من فيلم مدته 3 ساعات، والمصادفة بأنها رأت مشهد المعركة كاملا، وهو أقسى ما في الفيلم.
في صبيحة اليوم التالي قالت لي زوجتي: ”ترى حلمت بأجواء فيلم حرب القيامة الآن“ معقولة كيف؟ ”حلمت كأننا نتمشى على ضفاف الجزيرة والناس تتحرك في هدوء فجأة سمعنا أصوت طائرات حربية وإذا بها تغطي السماء وتلقي القنابل على البيوت والنخيل وسواحل البحر، والنيران تتصاعد، أدخنة وأغبرة والناس تركض مذعورة، وكنت تقول لي اختبئي بين جداول الماء“ المساقي ”قلت لك لا لا تعال نلتجئ داخل لحسينية في حفظ الإمام أو خلنا نذهب بسرعة نشوف أحوال أولادنا، ثم تركنا المكان ونحن نرى الجثث ممدة على الأرض، دماء وصراخ وعويل والناس في كرب عظيم“!
لقد ارتبط حلم زوجتي بما شاهدته في الفيلم لمدرسة أطفال وسط غابة فيتنامية قصفت دون أدنى رحمة، وهي ضمن المعركة البشعة في فيلم ”القيامة الآن“، قلت لها: ”هذا مجرد مشاهدة ربع ساعة أثر فيك الفيلم لهذا الحد، يا أم أولادي الله يحفظك ويحفظ كل أمهات العالم، من ويلات وعذابات الحروب، ترى الحال من بعضه“ أفصحت لها عن حلمي المرعب القديم وصدمتي المبكرة لرؤية أول فيلم في حياتي داخل قاعة سينما ضخمة ومغلقة، كان ذلك فيلما حربيا في سينما أرامكو عن فيتنام قبل 42 عاما.
إن الأفلام السينمائية معروفة سلفا بأنها تمثيل في تمثيل يلعب فيها المونتاج وبراعة المخرجين والممثلين وخدع التصوير والمؤثرات الصوتية، وحبكة السيناريو، كلها مجتمعة تترك أثرا في نفس المشاهد الذي ينسى بأن المسألة لا تتعدى سوى تمثيل وسيناريو معد وحوار محفوظ، ولكن هذا هو طبيعة الفن السابع جاذب وساحر يوهم المشاهد بصدق ما يرى.
إذا كانت مشاهدة فيلم حربي أفزعتنا وتسللت لنا حلما، إذا ما حال من يعيش الحرب ذاتها، ويتنقل بين أتون نيرانها ويعايشها ليل نهار ويشهد أهوالها؟، لذا صناع السينما يعرفون أهمية تأثيرها على الأفئدة والعقول فهم يمررون رسائلهم بطرق الإبهار والتشويق، والدراما الحربية مكلفة في إنتاجها لكنها أقل بكثير من تكلفة يوم واحد في الحرب الحقيقية.
ويبقى السؤال معلقا بعد أن تضع كل حرب أوزارها، من يسأل من؟ ومن يحاسب من؟ الجندي البائس أم الأبرياء الذين يتساقطون كالقرابين نذرا لهمزات الشياطين، أم المهجرين الذين اصطلوا بنار حروب العبث، المارون في المنافي أم اللاجئين في الأوطان المدمرة يعيشون كالغرباء.
وحدهم الضعفاء عليهم دفع أخطاء الأقوياء.