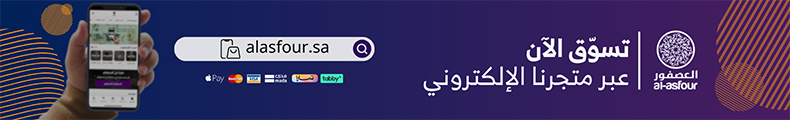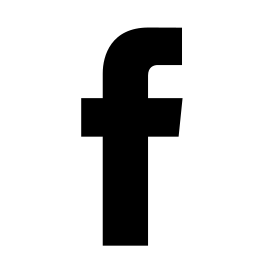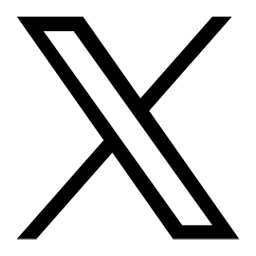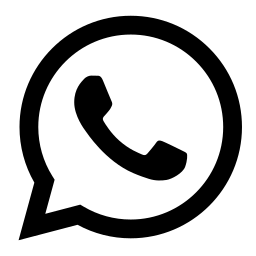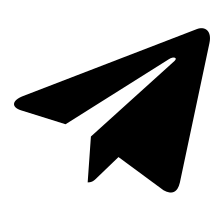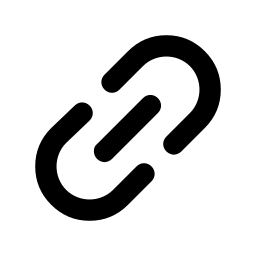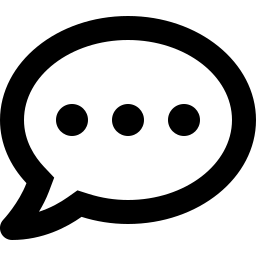ذكرياتنا وآفة النسيان
في كثير من الأحيان أجد نفسي في دوامة التساؤل التالي:
لماذا بعض ذكرياتنا منذ طفولتنا المبكرة تظل عالقة في الذهن دون غيرها، رغم تباعد السنين وكثرة الأحداث، التي تسجلها الذاكرة، وآفة النسيان التي لا تبقي ولا تذر؟
لا أريد أن ألتمس الإجابة من خطابات علماء النفس أو علماء الاجتماع أو من الذين تخصصوا في النفس البشرية واهتموا بدراستها من جميع الزوايا والاتجاهات. لقد سأل الكثير من الحبر حول هذه المسألة، فشُيدت مدارس ونظريات وفُندت أخرى. لكنني أريد الانطلاق من تجربة شخصية ثم أبني عليها قناعتي لاحقا.
ثمة ذكريات معينة تأتيني كلما فتحت باب الطفولة، وكأنها كامنة خلف الباب، وتنتظر أحدهم يفتحه؛ كي تندفع بقوة إلى الخارج. حتى تظن أنْ لا ذكريات ترتبط بطفولتك غيرها. وهو ظن كما أعتقد فيه شيء من الوهم. لأن مثل هذه الذكريات لا تمنحك الفرصة لكي ترفع رأسك، وتجول بعينيك في أرجاء بيت الذاكرة، وتلمس بيديك هذا الجدار أو ذاك، أو تتعثر بحصى هذه الغرفة أو تلك. لا شيء من ذلك يحدث أمام قوة واندفاعة تلك الذكريات.
كنت في السابعة من العمر، أقل أو أكثر، وكان جدي، بعد أن يأتي من سفره بعد طول غياب، حكّاء ماهرا، يروي الحكايات والقصص التاريخية الأسطورية بطريقة تجعلنا أنا وإخوتي مشدودين إلى تفاصيل وجهه أكثر من الانشداد إلى القصص نفسها.
من موقعي الآن أتأمل هذه التفاصيل وكأنها تحدث للتو واللحظة بينما هناك ذكريات كثيرة حدثت لاحقا وكانت مفصلية في حياتي، أتذكرها لكن ليست بتلك التفاصيل.
ثم اكتشفت أنني لست وحدي الذي يمر بهذه الحالة، بعض الأصدقاء كذلك على اختلاف مرجعياتهم الثقافية والتربوية، أيضا ما وقع على يدي من كتب الذكريات عند بعض الأدباء والشعراء والمفكرين والعلماء، عندها تكونت عندي قناعة مفادها أن أحداث الذاكرة عند الشخص عندما تروى بطريقة قصصية مؤثرة، فإن ما يروى يظل عالقا في الذاكرة أكثر من الحدث نفسه، فالحدث قد تغيب تفاصيله. لكن طريقة سرد الحدث هو الأكثر حضورا وقوة.
لذا هذا النوع من الذكريات المسرودة، إما تحضر بقوة من خلال ما يتهيأ لها من أسباب ومنعة كحالة ذكرياتي، وإما أن يكون الشخص نفسه يمتلك موهبة الراوي والسارد، بحيث يتمكن من سرد ذكريات حياته بعد أن يحولها على هيئة قصص.
وما يؤكد هذه القناعة عندي أكثر هو أن حياتنا منذ المولد إلى الممات ليست سوى سلسلة من القصص المتتابعة، ومَنْ تكون قصته أكثر إبهارا وإبداعا فإن الفن يحاول محاكاتها ومن ثم تحويلها إلى أيقونة خالدة في الذاكرة، هذا ما تقوم به السينما بامتياز.
لذلك عندما أزدهر أدب السيرة الذاتية والذكريات في الأدب الغربي مطالع القرن الثامن عشر كان الدافع الأكبر وراء هذا الازدهار هو إيمان الفرد بنفسه، وأن حياته تستحق أن تُروى، وأن تكتب. ولم ينمو هذا الدافع من فراغ، فبعد انتشار التعليم والكتابة وتطور المعرفة واللغة الأدبية والفكرية صار بوسع الكاتب في أي حقل كان أن يضع حياته بين دفتي كتاب. لكن مهما اجتهد هذا الكاتب أو ذاك في إبراز وتذكر أدق تفاصيل حياته، إلا أن ثمة فراغات لا يمكن ملأها بالحقائق الواقعية، بل تكون يد المخيلة مسعفة في هذه الحالة، وتكون لها دور كبير في ملء هذه الفراغات، إلا إذا استعان الواحد بالوثائق والنصوص المؤرخة من محطات حياته. ونادرا ما نصادف أشخاصا يمتلكون قوة الحافظة أو الذاكرة ودقتها، وفي نفس الوقت قوة المخيلة وصفائها كما هو عمل مارسيل بروست «البحث عن الزمن المفقود». أهمية مثل هذه الأعمال تضعنا أمام حقيقة لطالما اعتقدنا أننا لن نتجاوزها بالمطلق ألا وهي: مهما احتفظ المرء بذكرياته في الذهن لكن بالنهاية تستسلم ليد النسيان. لكننا بمثل هذه الأعمال قد تجاوزناها.