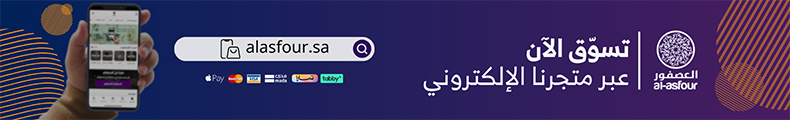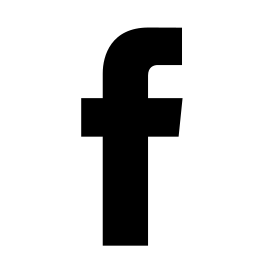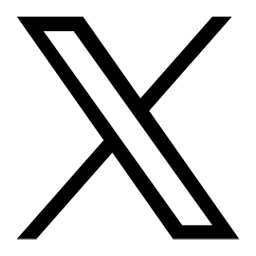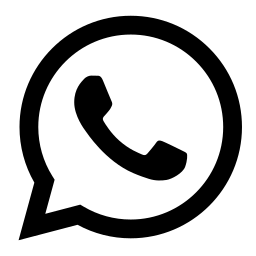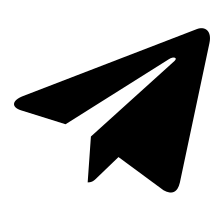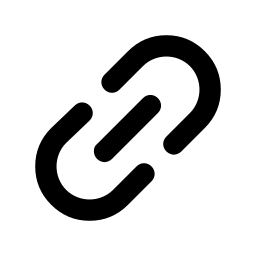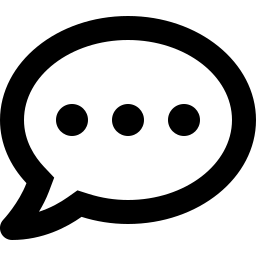العبق الفواح من سيرة الإمام الحسن المجتبى (ع) «2»
تجوال بين البساتين الحسنية:
الإمام الحسن  شعلة مضيئة في المسيرة الإنسانية والتاريخ البشري بما كان يحمله من مكارم أخلاقية ترفع شأن الإنسان وتعلي مقامه وقيمته، ففي حين أن البعض - على مر الزمان - قد لطخ صفحات التاريخ باللون الأسود لما تهاوى وهبط إلى عالم البهيمية المتوحشة، فأطلق العنان لأهوائه وجرى خلف بناء مجده الوهمي من خلال الاستبداد والطغيان والعدوان ماديا ومعنويا على الآخرين، فأهان بذلك الصبغة الإنسانية الجميلة والمتميزة والمتباينة عن عالم الحيوانية ومبدأ الغاب والافتراس، في مقابل ذلك نجد السيرة المشرقة لمن نثروا الورود والرياحين ورسموا الابتسامة على الوجوه البائسة، عظماء تخلصوا من ربقة الأغلال للمصالح الضيقة وعبودية المال والجاه والأنانية المقيتة، فانطلقوا في ميدان العطاء والبذل لكل إنسان بحسب حاجته فبلسموا الآلام وأزاحوا الكآبة والهموم، لم يقبعوا في زوايا بيوتهم توهما بأن السلامة في الدين والدنيا بالانزواء عن الناس ومجانبة العيش في أوساطهم، بل كانوا أطباء الأرواح فما إن يقترب منهم أحد إلا وتأنس نفسه برؤية وجوههم النورانية وتشرق باستماع كلماتهم وحكمهم التي تورث رشدا ونضجا في المدارك العقلية، ولا يخفى أن أهم طرق التربية السليمة والمثمرة هي القدوة الحسنة، وهكذا تربى على أيديهم من رأى الكمال الإنساني وعالم الفضيلة متجسدا في أفعالهم ومواقفهم، تنزهوا عن الرذائل والخطايا فتأثر بهم المؤمنون ممن صنعوا شخصياتهم فاكتسبوا البصيرة والاستقامة والثبات على الحق، وفي لجج الحياة ومحطاتها الصعبة قادوا الناس كقبس نور في وسط دياجير مظلمة يتيه فيها من لا يهتدي بهدي الأبرار الصالحين.
شعلة مضيئة في المسيرة الإنسانية والتاريخ البشري بما كان يحمله من مكارم أخلاقية ترفع شأن الإنسان وتعلي مقامه وقيمته، ففي حين أن البعض - على مر الزمان - قد لطخ صفحات التاريخ باللون الأسود لما تهاوى وهبط إلى عالم البهيمية المتوحشة، فأطلق العنان لأهوائه وجرى خلف بناء مجده الوهمي من خلال الاستبداد والطغيان والعدوان ماديا ومعنويا على الآخرين، فأهان بذلك الصبغة الإنسانية الجميلة والمتميزة والمتباينة عن عالم الحيوانية ومبدأ الغاب والافتراس، في مقابل ذلك نجد السيرة المشرقة لمن نثروا الورود والرياحين ورسموا الابتسامة على الوجوه البائسة، عظماء تخلصوا من ربقة الأغلال للمصالح الضيقة وعبودية المال والجاه والأنانية المقيتة، فانطلقوا في ميدان العطاء والبذل لكل إنسان بحسب حاجته فبلسموا الآلام وأزاحوا الكآبة والهموم، لم يقبعوا في زوايا بيوتهم توهما بأن السلامة في الدين والدنيا بالانزواء عن الناس ومجانبة العيش في أوساطهم، بل كانوا أطباء الأرواح فما إن يقترب منهم أحد إلا وتأنس نفسه برؤية وجوههم النورانية وتشرق باستماع كلماتهم وحكمهم التي تورث رشدا ونضجا في المدارك العقلية، ولا يخفى أن أهم طرق التربية السليمة والمثمرة هي القدوة الحسنة، وهكذا تربى على أيديهم من رأى الكمال الإنساني وعالم الفضيلة متجسدا في أفعالهم ومواقفهم، تنزهوا عن الرذائل والخطايا فتأثر بهم المؤمنون ممن صنعوا شخصياتهم فاكتسبوا البصيرة والاستقامة والثبات على الحق، وفي لجج الحياة ومحطاتها الصعبة قادوا الناس كقبس نور في وسط دياجير مظلمة يتيه فيها من لا يهتدي بهدي الأبرار الصالحين.
ومنهم الإمام الحسن الزكي  والذي حاز محبة وجاذبية في قلوب الناس إذ رأوا فيه امتدادا وتمثيلا للنهج النبوي المفعم بالأخلاق الرفيعة والتعامل الحسن مع الآخرين وخصوصا من أساؤوا له
والذي حاز محبة وجاذبية في قلوب الناس إذ رأوا فيه امتدادا وتمثيلا للنهج النبوي المفعم بالأخلاق الرفيعة والتعامل الحسن مع الآخرين وخصوصا من أساؤوا له  ، فقد كان
، فقد كان  رمزا ومعلما في الصبر وتحمل الأذى في سبيل نزع بذور الكراهية والشرور من القلوب المريضة، فضبط النفس وخلق الحلم وكظم الغيظ من أهم المباديء التي نتعلمها ونستقي معينها العذب من سيرته ومواقفه
رمزا ومعلما في الصبر وتحمل الأذى في سبيل نزع بذور الكراهية والشرور من القلوب المريضة، فضبط النفس وخلق الحلم وكظم الغيظ من أهم المباديء التي نتعلمها ونستقي معينها العذب من سيرته ومواقفه  ، فنحن نواجه في حياتنا الأسرية والاجتماعية الاحتكاكات وسوء الفهم والإساءة في تعاملاتنا، وليس لنا من نهج عملي يجنبنا ويلات الخصومات والمشاكل وتصاعد الكراهيات سوى النهج الحسني المفعم بالتسامح والتجاوز عن إساءة الغير، فالخيار الآخر وهو المواجهة مع الإساءة والخطأ والكلمة البذيئة بمثلها، مما يعني تأجج الخلافات والأحقاد بين أفراد المجتمع والخصومات المستحكمة، هذا بخلاف حالة الألم النفسي وفقدان التصالح معها بسبب الانفصام والتباين الناتج عن القيم الأخلاقية التي يحملها ومخالفتها عمليا وعلى أرض الواقع.
، فنحن نواجه في حياتنا الأسرية والاجتماعية الاحتكاكات وسوء الفهم والإساءة في تعاملاتنا، وليس لنا من نهج عملي يجنبنا ويلات الخصومات والمشاكل وتصاعد الكراهيات سوى النهج الحسني المفعم بالتسامح والتجاوز عن إساءة الغير، فالخيار الآخر وهو المواجهة مع الإساءة والخطأ والكلمة البذيئة بمثلها، مما يعني تأجج الخلافات والأحقاد بين أفراد المجتمع والخصومات المستحكمة، هذا بخلاف حالة الألم النفسي وفقدان التصالح معها بسبب الانفصام والتباين الناتج عن القيم الأخلاقية التي يحملها ومخالفتها عمليا وعلى أرض الواقع.
وقد يشكل البعض بأن حياة الأئمة  الأخلاقية والتربوية هي عالم المثاليات ومدينة الفضيلة التي لا يمكن التعامل بها اليوم ولا تتناسب مع عصرنا، من الجهة الأولى المتعلقة بذواتنا القاصرة عن بلوغ معشار فضائلهم وصعوبة الترقي في درجات التكامل والرقي كما كانت عليه نفوسهم الطاهرة، والجهة الأخرى تتعلق بمن حولنا حيث تسربت للنفوس حالة الغليان والضيق وسرعة الانفعال والتأهب السريع للدخول في الخلافات والخصومات لأبسط الأسباب، وهذا ما نراه ماثلا أمامنا في العلاقات الأسرية والمجتمعية والتي تضررت كثيرا بسبب ضعف الوازع الديني والشعور المتزايد بتحقيق الانتصار للنفس برد الضربة والكلمة بمثلها، والتعامل الأخلاقي في هذه الحالة قد يعد ضربا من الضعف ويؤول إلى التطاول على الشخص والذي لا يتوقع منه الإساءة بالبتة!!
الأخلاقية والتربوية هي عالم المثاليات ومدينة الفضيلة التي لا يمكن التعامل بها اليوم ولا تتناسب مع عصرنا، من الجهة الأولى المتعلقة بذواتنا القاصرة عن بلوغ معشار فضائلهم وصعوبة الترقي في درجات التكامل والرقي كما كانت عليه نفوسهم الطاهرة، والجهة الأخرى تتعلق بمن حولنا حيث تسربت للنفوس حالة الغليان والضيق وسرعة الانفعال والتأهب السريع للدخول في الخلافات والخصومات لأبسط الأسباب، وهذا ما نراه ماثلا أمامنا في العلاقات الأسرية والمجتمعية والتي تضررت كثيرا بسبب ضعف الوازع الديني والشعور المتزايد بتحقيق الانتصار للنفس برد الضربة والكلمة بمثلها، والتعامل الأخلاقي في هذه الحالة قد يعد ضربا من الضعف ويؤول إلى التطاول على الشخص والذي لا يتوقع منه الإساءة بالبتة!!
وهذا الإشكال يتبدد إذا عرفنا أن التكامل والرقي الأخلاقي ليس على درجة واحدة، فكل بحسب وسعه وطاقته يعمل جاهدا على تهذيب نفسه وتخليصها من الأهواء والنقائص، كما أن الخلق الرفيع له تأثير كبير على نزع بذور الشر والعدوان من النفوس، قال تعالى: ﴿.. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ . فصلت الآية 34.