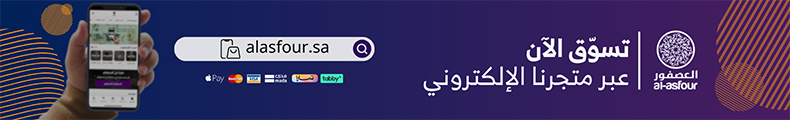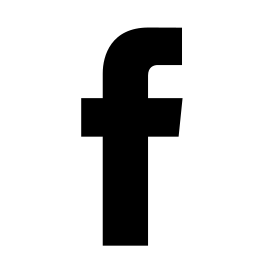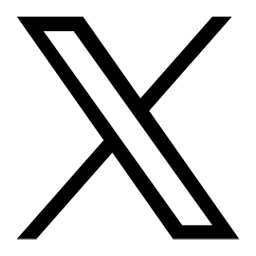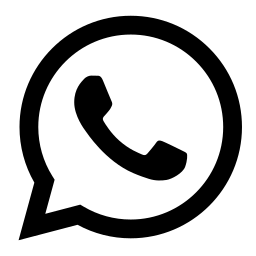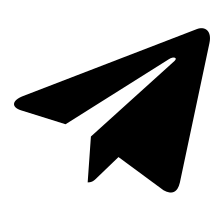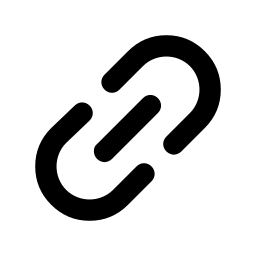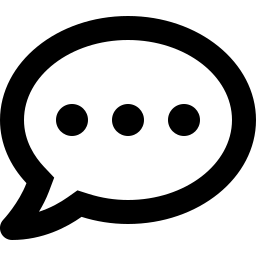مثاقفة محمد جابر الأنصاري الباريسية
 ذكرت في محاضرتي ”مع الأنصاري في توفيقيته صراع الأضداد“ مساء يوم 6 ديسمبر الماضي بمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالمحرق، أنني دعوت د. محمد جابر الأنصاري إلى كتابة مقال أسبوعي في جريدة الرياض الأسبوعي كل جمعة بين سنة 1982 و 1983 م… أحصيتها فوجدتها قرابة خمسين مقالًا، كان يرسلها لي كل أسبوع من باريس، حين كان الأنصاري يعمل مستشارًا ثقافيًا في سفارة خليجية بين سنة 1979 و 1983 م وهي مقالات تراوحت بين المعالجة السياسية والثقافية والأدبية، تحت عنوان ”مساحة للعقل العربي“.
ذكرت في محاضرتي ”مع الأنصاري في توفيقيته صراع الأضداد“ مساء يوم 6 ديسمبر الماضي بمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالمحرق، أنني دعوت د. محمد جابر الأنصاري إلى كتابة مقال أسبوعي في جريدة الرياض الأسبوعي كل جمعة بين سنة 1982 و 1983 م… أحصيتها فوجدتها قرابة خمسين مقالًا، كان يرسلها لي كل أسبوع من باريس، حين كان الأنصاري يعمل مستشارًا ثقافيًا في سفارة خليجية بين سنة 1979 و 1983 م وهي مقالات تراوحت بين المعالجة السياسية والثقافية والأدبية، تحت عنوان ”مساحة للعقل العربي“.
وقتذاك كان أفرغ وسعه وبذل جهده في أطروحته للدكتوراه، التي انتهى من مناقشتها سنة 1979 م في جامعة بيروت الأمريكية، محورها حول النزعة التوفيقية، مفصلًا التتبع التاريخي للتجارب السياسية والمداولات الفكرية في عصر العرب الحديث، ابتداءً من حملة نابليون على مصر سنة 1798 م إلى هزيمة 1967 م متوقفًا ودارسًا نقائضها المتراوحة، بين الوطنية والاستعمار والتراث والنهضة والأصالة والمعاصرة، وذلك في ما أصدره بعد ذلك من كتاب ضخم بعنوان ”الفكر العربي وصراع الأضداد“.
 غير أن ما لفت نظري في مقالاته الباريسية، خلوها من التفاعل الثقافي والأدبي، مع ما كان يدور في عاصمة الأنوار، من سجالات فلسفية وحراكات أدبية وفنية، طاولت بثوراتها قضايا وصرعات، لم تستثن الأزياء والمطبخ والألعاب الرياضية.
غير أن ما لفت نظري في مقالاته الباريسية، خلوها من التفاعل الثقافي والأدبي، مع ما كان يدور في عاصمة الأنوار، من سجالات فلسفية وحراكات أدبية وفنية، طاولت بثوراتها قضايا وصرعات، لم تستثن الأزياء والمطبخ والألعاب الرياضية.
وكما نعلم فإن باريس شكلت مثاقفة مستمرة في العالم العربي، منذ قامت الظاهرة الاستعمارية في بعض بلدانه، فزارها رحالة وأدباء وشعراء، وابتعث إلى جامعتها عدد من الطلاب العرب… وقد جسد علاقة الأنا العربي بالآخر الفرنسي عدد من أبرز الرحالة والروائيين، خاصة من خضعت بلدانهم للاستعمار الفرنسي - مشرقًا ومغربًا - بل إن هناك من يذهب إلى أن ترجمة أنطوان غالان ”ألف ليلة وليلة“ من العربية إلى الفرنسية في القرن الثامن عشر، ما كانت لتتم لولا مساعدة الرحالة الحلبي حنا دياب، الذي أضاف إلى الليالي قصة علاء الدين، كما اعترف غالان نفسه.
فكيف أغفل د. الأنصاري ما كان يجري في باريس من أفكار وآداب وفنون في مقالاته الخمسين وغيرها؟
بل إنه لم يتطرق إلى ما كتبه قبله من مفكرين عرب جدد، حول موضوعه النهضوي الأثير الذي انشغل به.
فقد كتب الأنصاري في مقاله ”جمود الفكر كيف نفسره“ بتاريخ 18 أبريل 1982 م:
”أن تكون ثمة أزمة في المجتمع وفي الأمة… معنى هذا أن هناك مخاضًا يجري وتحولًا من طور إلى آخر.. ومن سنة إلى أخرى… وأن شيئًا جديدًا يتبلور… أو لا بد أن يتبلور في نهاية المطاف مهما طال الزمن. ولكن أن تصل أزمة الثقافة والفكر إلى حد العقم والإفلاس مع كل هذه المعاناة التي نعانيها الأمة وأجيالها في مختلف المجالات.“
 ويتساءل الأنصاري في نهاية مقاله: ”فما بال فكرنا العربي في هذه الأيام لا يستجيب لهذا القانون… وما باله يشذ عن هذه القاعدة الحضارية الحياتية، رغم كل هذه الأزمات والمعاناة والنكبات القومية؟“.
ويتساءل الأنصاري في نهاية مقاله: ”فما بال فكرنا العربي في هذه الأيام لا يستجيب لهذا القانون… وما باله يشذ عن هذه القاعدة الحضارية الحياتية، رغم كل هذه الأزمات والمعاناة والنكبات القومية؟“.
قبل تاريخ سؤال الأنصاري بسنوات، كان المفكر المغربي عبدالله العروي بدأ ينشر مقالاته أواخر الستينات في مجلة ”دراسات عربية“ ومجلة ”مواقف“ اللبنانيتين حول تاريخ الأفكار والنقد الأيديولوجي، وفي سنة 1970 م فاجأ الساحة العربية بأطروحته العميقة المنشورة في بيروت سنة 1970 م حول ”الأيديولوجيا العربية المعاصرة“ بمقدمة المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون الضليع في دراسة المجتمعات وتحليل الأفكار في العالم العربي والإسلامي، وقد ترجم الكتاب الباحث اللبناني محمد عيتاني، الذي بدأ - وقتذاك - ينشر دراساته عن الفكر الإسلامي والقرآني بمنظور ماركسي.
وقد ذهب العروي في كتابه أن الأيديولوجيا ليست شقشقة لسان فارغة لا معنى لها، بل حاول أن يظهر في كتابه اللافت أنها ذات دلالة وفكر منظم متماسك، هدفت إرشاد المصلحين إلى مسالك العمل والإنجاز، لكنه في الوقت نفسه كشف أنها تستعيد منطق تطور الغرب في سياق تطور التاريخ الحديث، واصفًا هذه الأيديولوجيا العربية بالتعالي المستقل عن حركة المجتمع العربي، مدللًا على وجود تماثل عاضوي وبنيوي بينه وبين سيرورة العقل الحديث.
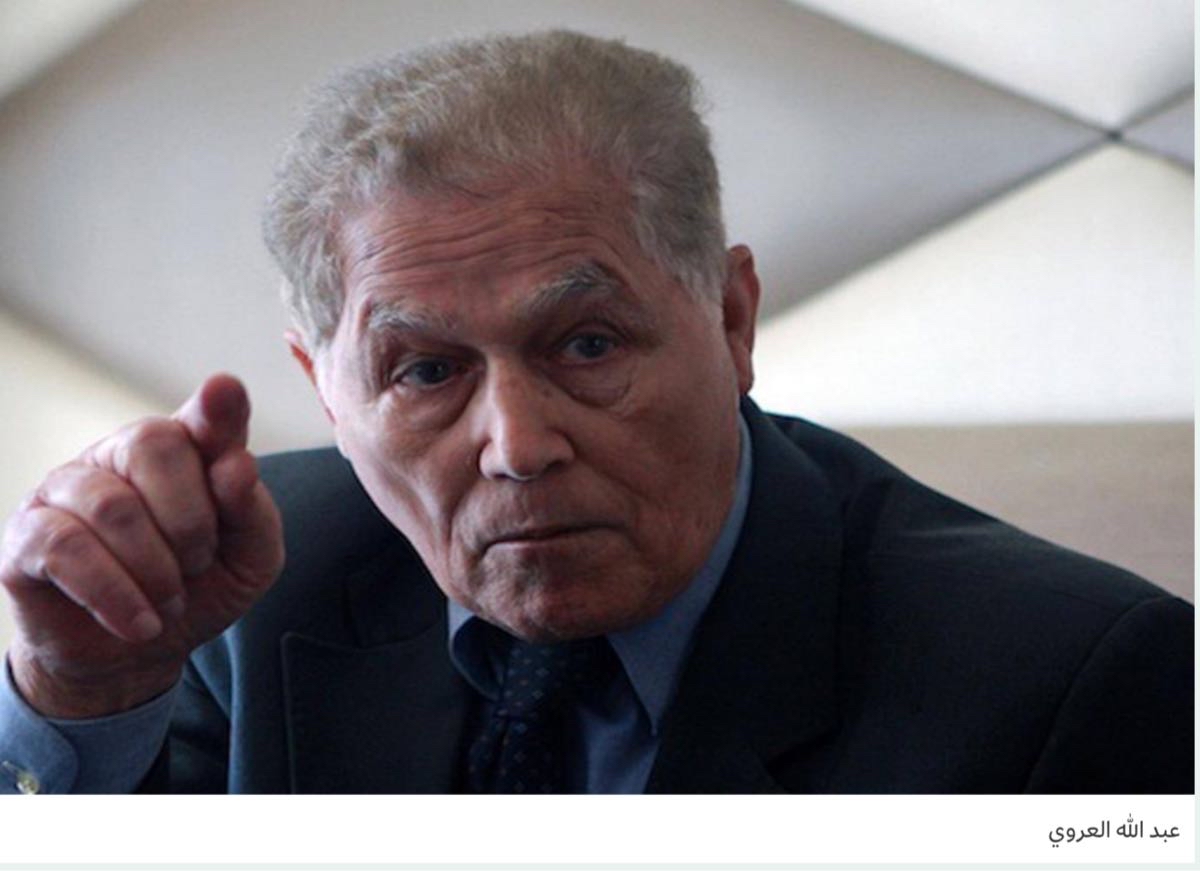 أما كتابه الآخر ”العرب والفكر التاريخي“ الصادر سنة 1974 م فأول ما سمعت به على لسان القاص المصري يوسف إدريس، وأنا أزوره في منتجعه الصيفي على شاطئ الإسكندرية، واقتنيته إثر ذلك من مكتبة مدبولي بالقاهرة، فوجدت العروي يتطرق في مؤلفه إلى استلاب الفكر العربي المعاصر بشقيه التقليدي والعصري، باحثًا عن كيفية استيعاب الفكر العربي للفكر الليبرالي طريقًا نحو فكر تقدمي، معالجًا أوضاع التأخر العربي عن ركب العالم الحديث، وداعيًا المثقف العربي أن ينفلت نهائيًا عنها بالنفاذ إلى الجذور، محذرًا أن يكون العرب آخر شعب يقوم من سباته، رغم أنه عرف أول نهضة فكرية في العالم الثالث، داعيًا إلى اجتثاث الفكر التقليدي… وحينما يرد عليه بأن ثقافتنا المعاصرة هذه ستكون تابعة لثقافة الغير، يجيب العروي وهو يرفع لواء القطيعة مع التراث… فليكن ذلك!
أما كتابه الآخر ”العرب والفكر التاريخي“ الصادر سنة 1974 م فأول ما سمعت به على لسان القاص المصري يوسف إدريس، وأنا أزوره في منتجعه الصيفي على شاطئ الإسكندرية، واقتنيته إثر ذلك من مكتبة مدبولي بالقاهرة، فوجدت العروي يتطرق في مؤلفه إلى استلاب الفكر العربي المعاصر بشقيه التقليدي والعصري، باحثًا عن كيفية استيعاب الفكر العربي للفكر الليبرالي طريقًا نحو فكر تقدمي، معالجًا أوضاع التأخر العربي عن ركب العالم الحديث، وداعيًا المثقف العربي أن ينفلت نهائيًا عنها بالنفاذ إلى الجذور، محذرًا أن يكون العرب آخر شعب يقوم من سباته، رغم أنه عرف أول نهضة فكرية في العالم الثالث، داعيًا إلى اجتثاث الفكر التقليدي… وحينما يرد عليه بأن ثقافتنا المعاصرة هذه ستكون تابعة لثقافة الغير، يجيب العروي وهو يرفع لواء القطيعة مع التراث… فليكن ذلك!
هذا هو ما كان بدأ يتطارحه - وقتذاك - د. زكي نجيب محمود، وقد عاد من مغتربه البريطاني إلى كرسي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، ليعود متأخرًا إلى دراسة التراث العربي والإسلامي برؤية عصرية، تجلت في كتابه ”تجديد الفكر العربي“ وكتابه ”المعقول واللامعقول في تراثنا العربي“. داعيًا المفكرين العرب من وحي الفلسفة الوضعية، إلى صياغة مشروع فكري عربي جديد.
ولم يكن العروي المهمل وحده في اهتمام الأنصاري الفكري - كما يتجلى لا في مقالاته الباريسية وحدها وإنما كذلك في أطروحته ”الفكر العربي وصراع الأضداد“ فهو مثلًا لم يتطرق قط إلى ما تطارحه المفكر السوري د. طيب تيزيني أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق، إذ أصدر كتابه ”مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط“ سنة 1971 م في دمشق وكان الكتاب متداولًا في أوساط اليسار في المشرق العربي، وهو ينبههم إلى ما في التراث الفكري العربي من ظواهر اجتماعية وفكرية ثورية، سبقه إلى استثارتها كتاب ”تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام“ لبندلي جوزي ”1878 - 1942 م“ الباحث الفلسطيني الذي استوطن روسيا قبل الثورة البلشفية على القياصرة وعاش فيها بعدها، وقد حصل على الدكتوراه حول المعتزلة في جامعة قازان، وأصبح أستاذًا للفلسفة الإسلامية في جامعة باكو لسنوات، وله العديد من الدراسات الفكرية والأدبية واللغوية.
أما على الصعيد الأدبي والفني فقد تناول الأنصاري في 22 يوليو 1983 م مقالا بعنوان ”جديد باريس… فن بدائي يمد لسانه لبيكاسو“ انتقد فيه بشدة الفن التشكيلي الحديث، مقارنًا ما شاهده في باريس من لوحات فنية غمض عليه فهمها، وقد أصبحت مدرسة وحركة فنية، ولوحات مؤثرة عالمية، لا يحصيها العد لفنانين من مختلف دول أوروبا الغربية والشرقية، وقد احتلوا لأنفسهم مكانة في ساحة الفن بباريس… مقارنًا هذه اللوحات بما كان يشاهده صبيًا وشابًا على جدران دكاكين الهنود وعلى واجهات محالهم في أحياء المحرق! وهي تصور الريف البسيط وموكب المهراجا بزخارفه المترفة، ومسيرة الأفيال بسروجها البراقة، وأعراس الفلاحين ومواسم الحصاد ولهو الأطفال، ومهرجان المياه الملونة التي يتراشق بها الهنود في الأعياد.
نعم إنه بحساسيته الفنية الرومانسية وحنينه النوستالجي، يقارنها بما شاهده في ساحة الفن بباريس الثمانينات، واصفًا إياها بأنها مسورة بأكثر من سياج مادي ومعنوي وفني، إذ لا تستطيع اقتحامها، ما لم تكن سورياليًا أو تكعيبيًا، إذ يرى أنها ذهبت ببساطة الفن الأصيل الجميل، ونفرت الناس منه، فكلما كانت اللوحات مغرقة في الغموض والسوداوية والتشاؤم مثقلة بالرموز حافلة بالنقائض والمعاني العكسية - وهذا ما ينطبق على تجربة بيكاسو المتعاقبة بين الواقعية والسوريالية والتكعيبية كما تجلت في لوحته الشهيرة ”الغرنيكا“ - زاد حظك من القبول لدى كهان الفن الباريسي، الذين لم يمد لهم بيكاسو لسانه!
ولا يقتصر نقد الأنصاري الساخر اللاذع على ظاهرة الفن الحديث، وإنما يصب جام غضبه كذلك على نقاده، الذين يزيدون غموض هذه اللوحات غموضًا بقراءاتهم النقدية… في حين يعترف أن هذه الظاهرة لم تنبت من فراغ، ولم تظهر دون مبررات، فهي تعبر عن التأزمات النفسية للحضارة الغربية، مشوبة بفكرة اللاوعي الفرويدي، والتشاؤم والعبث الوجودي.
ويواصل د. الأنصاري تذمره من ظواهر باريس الأدبية والشعرية في مقال آخر عنونه بـ ”أدب اللامعقول… هل يتفق وإيقاظ العرب“ داعيًا فيه الشباب العربي إلى أن لا يقعوا في الإشكالية التي وقع فيها التيار السوريالي العربي المعاصر في لبنان، بتأثره الميكانيكي بما كان يحدث في فرنسا من رد فعل على طغيان الموجة العقلانية الواقعية، قادت بعض شعرائه ”بريتون“ خاصة إلى كتابة شعر خرج على المألوف الفني، معبرًا عن التقلبات النفسية التي عاشتها فرنسا، بعد الحربين العالميتين، وقد عجز العقل الاجتماعي والثقافي من استيعاب آثارها على النفسية الاجتماعية.
العجيب هنا أن الأنصاري الذي نشر مقاله في 22 أبريل 1983 م كان الناقد العراقي علي الشوك قد تناوله بإحاطة شاملة في كتابه ”الدادية“ المنشور في بيروت سنة 1970 م، كما أنه كتب عن السوريالية وتبدياتها العربية في قصيدة النثر والفن التشكيلي، الكثير من الدراسات النقدية والمقالات الصحفية، منذ بداية بروزها على يدي اللبناني بشر فارس، بعد عودته من الدراسة الأكاديمية في ألمانيا، وبدأ ينشر منذ الثلاثينات الميلادية قصائده النثرية ومقالاته النقدية التجديدية، فوق صفحات مجلة رسالة الزيات التقليدية!.
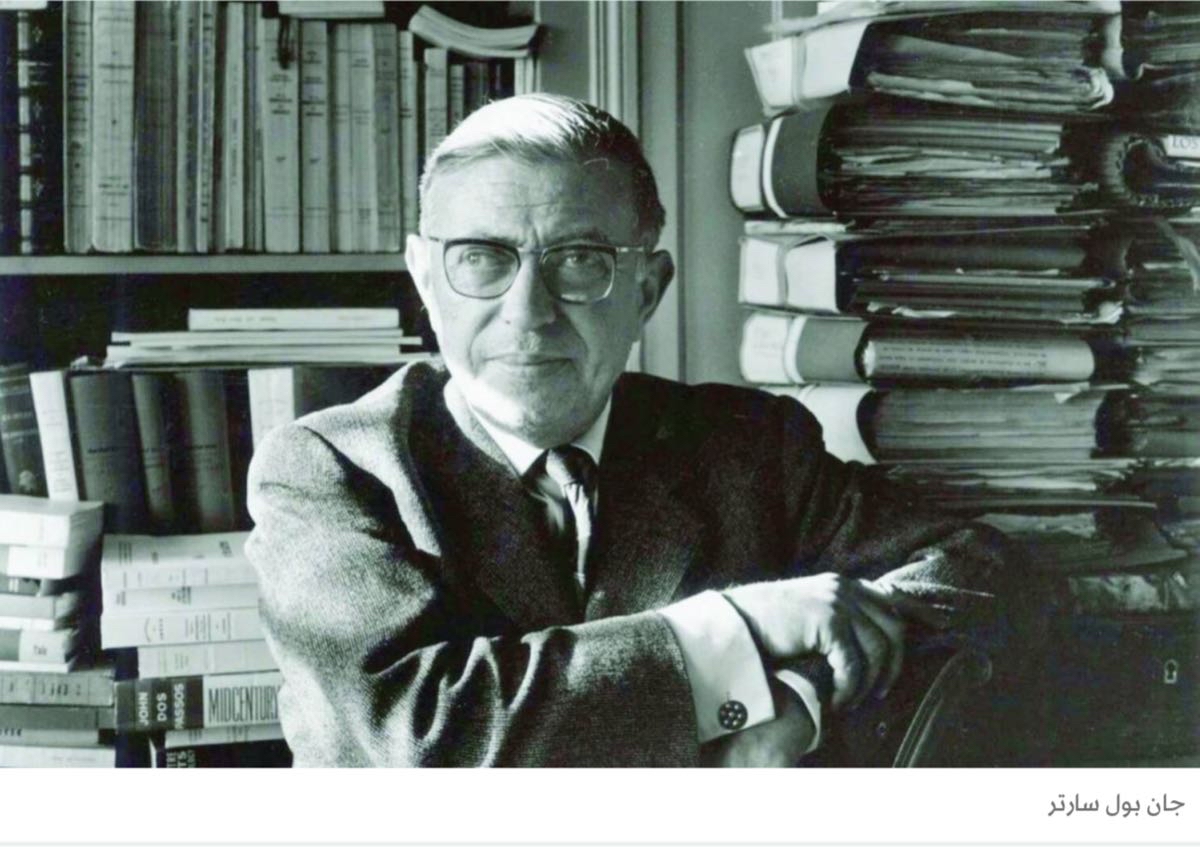 هذا وفي الوقت الذي ينشر الأنصاري مقالاته هذه من باريس، حيث عاش فيها بين سنة 1979 وسنة 1983 م كانت باريس تضج بحراكها الفلسفي والفكري والنقدي والشعري والفني، وقد استوعبت كافة المذاهب والتيارات من ماركسية ووجودية وحداثية وما بعد حداثية، من بنيوية وألسنية وتفكيكية وسيمولوجية، لم تكن حينها بعيدة عن متابعة القارئ العربي… فهذا هو جورج طرابيشي يترجم سنة 1979 م كتاب ”البنيوية“ لروجيه غارودي الفيلسوف والناقد الأدبي المعروف لدى القراء العرب، وقد خلص إلى أنها تنتهي بموت الإنسان، في أعقاب صرخة نيتشه الغاضبة المتمردة على الإله الكنسي، فدي سوسير أو جاكوبسون أو ليفي ستراوس، لم يزعموا أن البنيوية كلية المعرفة، في حين أنها ترد كل واقع إلى البنية، دون أن ترجعها إلى النشاط الإنساني المولد لها، هذا رغم استقاء فلاسفة البنيوية أولئك تنظيراتهم من ماركس في نظريته عن الصراع الطبقي بين البنية التحتية والبنية الفوقية، بوصف الفرد ثمرة العلاقات الاجتماعية المتصارعة، وتفسيره المادي للتاريخ البشري، وجاء تيار ما بعد الحداثة والبنيوية ليلغي عقلانية الحداثة، بوصف تمركز عقلانيتها في أوروبا، وهذا ما اعتبره جاك دريدا الفرنسي المولود في الجزائر، تمركزا عرقيا أبيض، وقد قام بتفكيكيته إلغاء ثنائياتها المتضادة بين الجسد والعقل والمجتمع والفرد والسيطرة والخضوع والمذكر والمؤنث… كل هذه التنظيرات ذات الدعاوى ”العلمية“ وما أسفر عنها في معالجات الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس والأدب، جاء ثمرة لحروب أوروبا الأهلية المئة والحربين العالميتين فيما بعد، بين إقطاعييها ونبلائها، ونازييها وليبرالييها، لتطلق بعد ذلك أسئلة حارقة ومحترقة من التأزم النفسي لدى فرويد في تحليله، والقلق والاغتراب الوجودي الممزق بين الإيمان والإلحاد، لتنتهي عند ميشيل فوكو في نهاية الإنسان، فهو بزعمه كما يلتفت غارودي ليست أقدم المشكلات الفلسفية التي انطرحت على المعرفة الإنسانية، ولا تتوقف هذه ”النهاية“ عند رولان بارت السميواوجي ”الإشاري“ المتوفي أمام إشارة مرور! في حادث سير في أحد شوارع باريس سنة 1980 م… نعم لا تتوقف لديه بأطروحته حول ”موت المؤلف“ ليتيح لـ ”متلقي“ النص الإبداعي إعادة إنتاج علاماته وإشاراته، وفق بنيته النفسية وتكوينه المعرفي، في علاقة جمالية تفاعلية بين النص والمتلقي، تحرر العمل الإبداعي من هيمنة التفسير الأحادي… هكذا انشغل أساتذة اللغة الأكاديميين ونقاد الأدب والأنثربولوجيا وعلم الاجتماع في مغرب العرب ومشرقه - منذ ذاك - بالبنيوية والألسنية والسيمولوجية والتفكيكية، في دراسة النصوص وتحليل الظواهر الاجتماعية وصياغة المشروعات الفكرية.
هذا وفي الوقت الذي ينشر الأنصاري مقالاته هذه من باريس، حيث عاش فيها بين سنة 1979 وسنة 1983 م كانت باريس تضج بحراكها الفلسفي والفكري والنقدي والشعري والفني، وقد استوعبت كافة المذاهب والتيارات من ماركسية ووجودية وحداثية وما بعد حداثية، من بنيوية وألسنية وتفكيكية وسيمولوجية، لم تكن حينها بعيدة عن متابعة القارئ العربي… فهذا هو جورج طرابيشي يترجم سنة 1979 م كتاب ”البنيوية“ لروجيه غارودي الفيلسوف والناقد الأدبي المعروف لدى القراء العرب، وقد خلص إلى أنها تنتهي بموت الإنسان، في أعقاب صرخة نيتشه الغاضبة المتمردة على الإله الكنسي، فدي سوسير أو جاكوبسون أو ليفي ستراوس، لم يزعموا أن البنيوية كلية المعرفة، في حين أنها ترد كل واقع إلى البنية، دون أن ترجعها إلى النشاط الإنساني المولد لها، هذا رغم استقاء فلاسفة البنيوية أولئك تنظيراتهم من ماركس في نظريته عن الصراع الطبقي بين البنية التحتية والبنية الفوقية، بوصف الفرد ثمرة العلاقات الاجتماعية المتصارعة، وتفسيره المادي للتاريخ البشري، وجاء تيار ما بعد الحداثة والبنيوية ليلغي عقلانية الحداثة، بوصف تمركز عقلانيتها في أوروبا، وهذا ما اعتبره جاك دريدا الفرنسي المولود في الجزائر، تمركزا عرقيا أبيض، وقد قام بتفكيكيته إلغاء ثنائياتها المتضادة بين الجسد والعقل والمجتمع والفرد والسيطرة والخضوع والمذكر والمؤنث… كل هذه التنظيرات ذات الدعاوى ”العلمية“ وما أسفر عنها في معالجات الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس والأدب، جاء ثمرة لحروب أوروبا الأهلية المئة والحربين العالميتين فيما بعد، بين إقطاعييها ونبلائها، ونازييها وليبرالييها، لتطلق بعد ذلك أسئلة حارقة ومحترقة من التأزم النفسي لدى فرويد في تحليله، والقلق والاغتراب الوجودي الممزق بين الإيمان والإلحاد، لتنتهي عند ميشيل فوكو في نهاية الإنسان، فهو بزعمه كما يلتفت غارودي ليست أقدم المشكلات الفلسفية التي انطرحت على المعرفة الإنسانية، ولا تتوقف هذه ”النهاية“ عند رولان بارت السميواوجي ”الإشاري“ المتوفي أمام إشارة مرور! في حادث سير في أحد شوارع باريس سنة 1980 م… نعم لا تتوقف لديه بأطروحته حول ”موت المؤلف“ ليتيح لـ ”متلقي“ النص الإبداعي إعادة إنتاج علاماته وإشاراته، وفق بنيته النفسية وتكوينه المعرفي، في علاقة جمالية تفاعلية بين النص والمتلقي، تحرر العمل الإبداعي من هيمنة التفسير الأحادي… هكذا انشغل أساتذة اللغة الأكاديميين ونقاد الأدب والأنثربولوجيا وعلم الاجتماع في مغرب العرب ومشرقه - منذ ذاك - بالبنيوية والألسنية والسيمولوجية والتفكيكية، في دراسة النصوص وتحليل الظواهر الاجتماعية وصياغة المشروعات الفكرية.
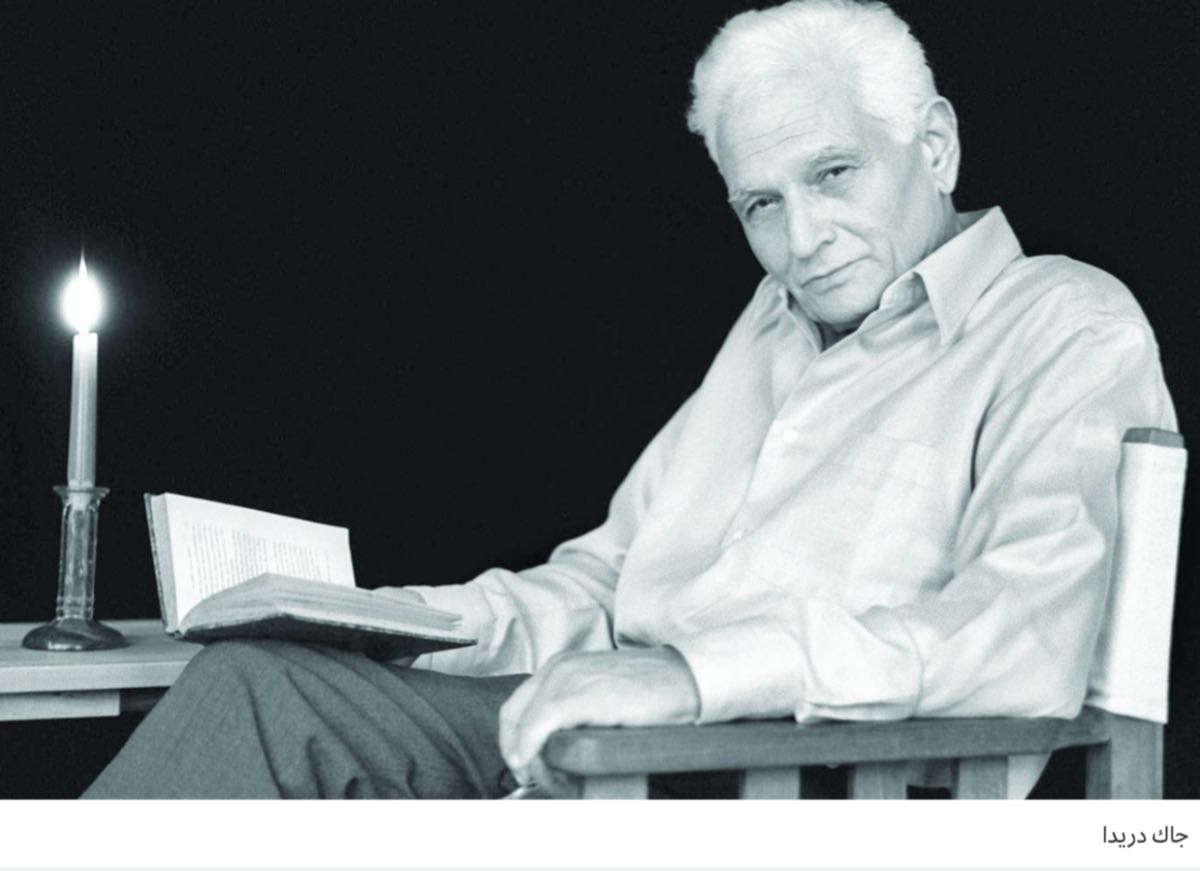 فلماذا يا ترى لم نر أثرًا أو بعض أثر من هذه الحمولة الفكرية والأدبية والفنية الباريسية المثقلة، في مقالات د. الأنصاري الخمسين، التي كان يرسلها لي كل أسبوع من باريس على مدى عامي 1982 و 1983 م؟
فلماذا يا ترى لم نر أثرًا أو بعض أثر من هذه الحمولة الفكرية والأدبية والفنية الباريسية المثقلة، في مقالات د. الأنصاري الخمسين، التي كان يرسلها لي كل أسبوع من باريس على مدى عامي 1982 و 1983 م؟
هل لأن ثقافة الأنصاري ظلت عربية وأنجلوسكسونية متشبثة به، أو قل متشبثًا بها أمام سيل جارف من الفلسفات والتنظيرات والآداب والفنون.
 ربما يكمن الجواب في مقاله المنشور في مقاله ”الموقف لا الالتزام“ بتاريخ 30 سبتمبر 1983 م معاودًا ما سبق وأن تطارحه والشاعر د. غازي القصيبي من سجال أدبي حول الالتزام أواخر الستينات الميلادية، وهما في أوج شبابهما في البحرين، حيث ساد التأثر سياسيًا بالفكر القومي وأدبيًا بالواقعية الاشتراكية، بعد هزيمة 67 قبل هذا كان مصطلح الالتزام يروج في كتابات بعض الأدباء العرب في مصر ولبنان والعراق، بعدما تحدث عنه د. طه حسين في إحدى مقالاته بمجلة الكاتب المصري منتصف الأربعينات، متحدثًا عن كتاب ”ما الأدب“ للفيلسوف والأديب الفرنسي الوجودي جان بول سارتر، وهو يربط الموقف الوجودي الحر بالالتزام الاجتماعي والسياسي المسئول، مناصرا وقتذاك الثورة الجزائرية، وقد ترجمه إلى العربية جورج طرابيشي، بعد ذلك في منتصف الستينات الميلادية وكتابه الآخر ”الأدب الملتزم“ الصادرين عن دار الآداب البيروتية لصاحبها د. سهيل إدريس الذي ترجم وزوجته عايدة مطرجي، عددًا من كتب سارتر وصديقته سيمون دو بوفوار الفلسفية وبعض رواياتهما الوجودية.
ربما يكمن الجواب في مقاله المنشور في مقاله ”الموقف لا الالتزام“ بتاريخ 30 سبتمبر 1983 م معاودًا ما سبق وأن تطارحه والشاعر د. غازي القصيبي من سجال أدبي حول الالتزام أواخر الستينات الميلادية، وهما في أوج شبابهما في البحرين، حيث ساد التأثر سياسيًا بالفكر القومي وأدبيًا بالواقعية الاشتراكية، بعد هزيمة 67 قبل هذا كان مصطلح الالتزام يروج في كتابات بعض الأدباء العرب في مصر ولبنان والعراق، بعدما تحدث عنه د. طه حسين في إحدى مقالاته بمجلة الكاتب المصري منتصف الأربعينات، متحدثًا عن كتاب ”ما الأدب“ للفيلسوف والأديب الفرنسي الوجودي جان بول سارتر، وهو يربط الموقف الوجودي الحر بالالتزام الاجتماعي والسياسي المسئول، مناصرا وقتذاك الثورة الجزائرية، وقد ترجمه إلى العربية جورج طرابيشي، بعد ذلك في منتصف الستينات الميلادية وكتابه الآخر ”الأدب الملتزم“ الصادرين عن دار الآداب البيروتية لصاحبها د. سهيل إدريس الذي ترجم وزوجته عايدة مطرجي، عددًا من كتب سارتر وصديقته سيمون دو بوفوار الفلسفية وبعض رواياتهما الوجودية.

لقد ارتبط مصطلح الالتزام بسارتر المتوفي وقت وجود د الأنصاري في باريس! بعد أن خلط منزعه الوجودي ببعض الأفكار الماركسية، إثر مقاومة فرنسا للاحتلال النازي… وهذا ما لم أره في إحدى مقالات د. الأنصاري، موضحًا في مقاله الباريسي، أن مصطلح الالتزام أصبح يشكو من اسمه! أي من مصطلحه الذي ارتبط بحمولة أيديولوجية، داعيًا إلى إلغاء كلمة الالتزام، وذلك بعدما انفض السامر القومي والالتزام الأيديولوجي، في مجتمع معظم مثقفي العرب وأدبائه، خاصة بعد زيارة سارتر إلى إسرائيل، عقب زيارته الشهيرة إلى مصر سنة 1967 م، مستذكرًا سجاله القديم مع صديقه د. غازي، وقد اكتشف أثناء قراءة ديوانه ”الحمى“ الذي صدر بعد زيارة الرئيس أنور السادات القدس سنة 1977 م، قصيدة غاضبة ضدها نشرتها للدكتور غازي القصيبي في جريدة الرياض بعنوان ”لا تهيئ كفني“ واصفًا إياها بأنها في ذروة الالتزام قائلًا في مقاله ذاك:
«اكتشفت طوال الوقت أني كنت أحاول أن أبيع الالتزام لشاعر ملتزم حتى أخمص قدميه، محاولًا إقناع غازي بأن يقبل منه تغيير مصطلح الالتزام إلى الموقف».