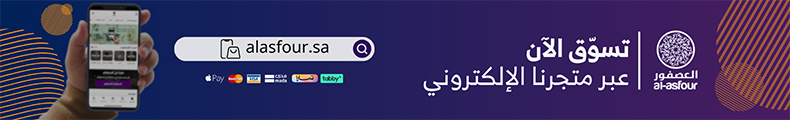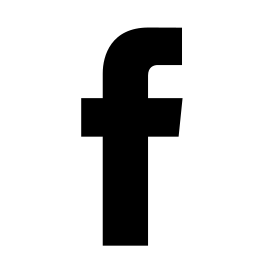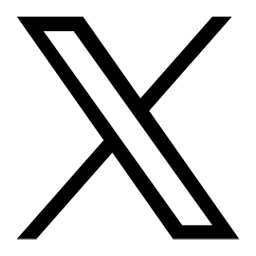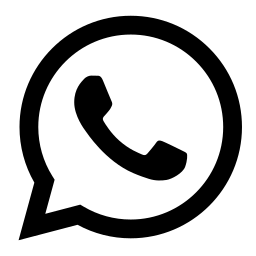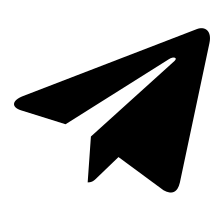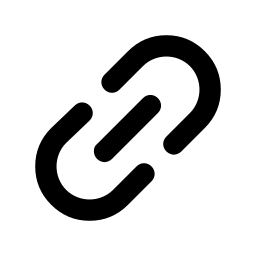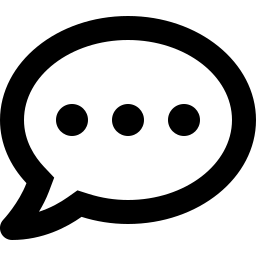فمن عفا وأصلح
نقابل من الناس من يجد في إطلاق العنان لمشاعره الانفعالية وإفساح المجال للسانه السليط ليضرب أنى شاء، مظهرا من مظاهر الوجود والقوة والهيبة الاجتماعية التي يتمتع معها، حيث يحسب له الحساب الدقيق في أي حديث أو تعامل معه، كما أن الإساءة والشتم والبداءة اللفظية والتجاهل والتسقيط وبقية الأساليب الاستفزازية بالتأكيد تعبر عن مكنون شخصية المرء وما يحمله من مفردات التربية الخاطئة، وما ترسب في نفسه من محيطه الاجتماعي والأسري من شوائب تنم عن تلقيه لألوان سلوكية سلبية.
وما تحمله من رقي أخلاقي وأدب سلوكي رفيع لا يمنحك شيئا من الحصانة والمنعة من مقابلة تعاملك الجميل بالإساءة والتهكم واللمز، فنحن في مجتمعنا نواجه شخصيات متعددة لا تقف على عتبة واحدة من التعامل، ولذا فمن الأكيد أنك ستلاقي تعاملا فظا وممجوجا غير مقبول - في كل الأعراف والقيم - دون أن يصدر منك أي هفوة أو إهانة أو انتقاص له، فالقلوب السوداء الممتلئة حقدا وتغيظا والتي تغلي فيها مشاعر الكراهية، والنفوس غير المهذبة والخالية من أدنى درجات الرقي في التخاطب والتعامل، ستلقى منهم تطاولا وسلاطة في اللسان وتعاملا أرعن، فكيف يمكن لنا التعامل مع هذا الهجوم المفاجئ والفعل المشين؟
هناك من يرى مبدأ التعامل بالمثل بل والكيل بمكيالين والرد العنيف الذي يوقف المسيء عند حده ويعيده لرشده، ويعتقد أن السكوت عن المسيء سيكلفنا غاليا إذ سنعتبر وجودا ضعيفا ينال منه ويسيء له الكثير من الناس!
الحقيقة أن هذا التفكير خاطئ جدا، إذ يتطلب منا جهدا مرهقا ومزيدا من دوامة التوترات المتصاعدة، وذلك أن الدخول في الصراعات والخلافات والمهاترات وردود الأفعال الانفعالية سيسلبنا راحة البال والهدوء النفسي، كما أنه يحولنا إلى نماذج مشابهة تماما للمسيئين بعد أن تعاملنا بنفس أساليبهم المعيبة والمشينة، ويملأ قلوبنا بالأحقاد والمشاعر السلبية تجاه كل من أساء لنا، ونفتقد حينها ثقافة التسامح والعفو والتي تعد أداة الإصلاح الاجتماعي المهمة.
ليس هناك من طريق يحافظ على قيمنا الأصيلة والتربية السليمة التي نشأنا عليها، ويبقي قلوبنا نقية لا تعرف الكره والبغض لأحد، سوى ثقافة العفو والتجاوز عن المسيئين.