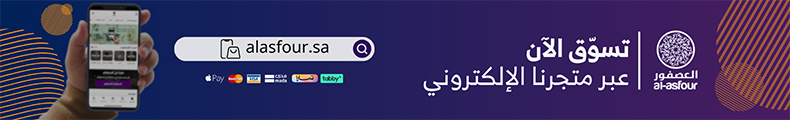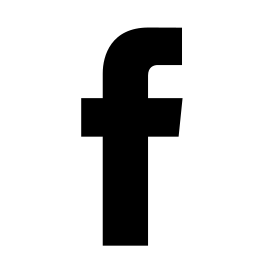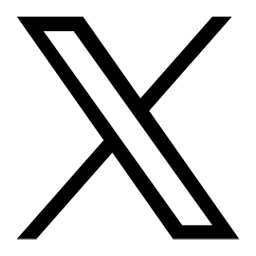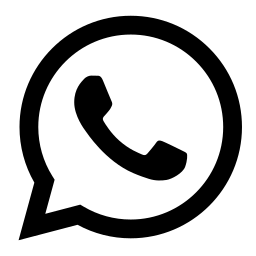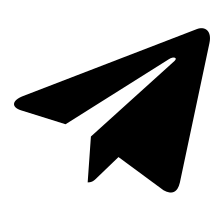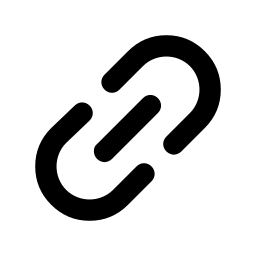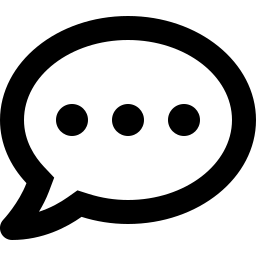أمي من فريق الأطرش «4»
كم شكوت للنخيل حالي لزمن عثرات الطفولة، عن أيام دراسية مضنية بين صقيع البرد وسموم الصيف، لمدرسة بلا كهرباء ولا ماء وفصول خالية من الكراسي، افترشنا ”حنبلا“ رقيقا يوجع عظامنا الرخوة، نتعب من كثرة الجلوس ونرتجف أثناء الكتابة وملء فراغات الحساب، يداي تتلوى ضربا وتحمر، حتى عطر الأستاذ رهبة، أضوج من الأجواء التعليمية المضجرة أحيانا، خشية عقاب بعدم اتمام الواجب أو تسميع أُنشودة. من شدّة الخوف ينعقد لساني وأبول في ثيابي، كرهت المدرسة أياما وشهورا، وأحببتها سنينا، كنت أخشى الدخول للصف ورؤية السبورة السوداء التي ارتطم رأسي بها رعبا ووجلا، أرتعد من وقفات المعلم وإيقاع حذائه الآتي إلى حقيبتي تفتيشا لأني نسيت كتابا أو دفتر ا، أصرخ ألما من شدة الجلد على خلفياتنا وأتعفّر، زميلي سيد محمد يلبس خمسة ”هافات“ للتخفيف من قسوة ”الفلَكة“ وما أشدّ الخيزرانة حين تهوي على جلودنا الغضة، حتى الجلوس يوجعنا، وكأن كل شيء من حولنا لا يرحم، لكنني أحببت كل مدرسي الرسم من محمود الطبل إلى أحمد أبو الهيجاء إلى مصطفى العكاوي وعلي داوود، فنانون أطلقوا العنان لخيالي. وبين فوضى الحواس، يشتد بي العذاب إذا هدّدني مجموعة طلاب أكبر مني سنا وقالوا لي ”بتروح في ستين داهية“ وأظن بأن الداهية ستنهي حياتي، لا أعرف معناها ولا حجمها، أتصورها احتمالا بأنها عاصفة ستقتلعني من الأرض وسأختفي من الوجود، ينهشني الخوف ويزيدني افتراسا إذا قال لي أحدهم ”بنوريك شغلك وقت الهدّه“ واضعا ابهامه وسبابته عند رقبته، حركة تحدي بأنه سيخنقني شنقا، أضطرب، أكتئب، أعيش الفراغ معلقا بلا معنى، لا أحد يدافع عني أو يحميني من البطش، دفاعي عن نفسي عسير، يحاصرني الضيق من كل جانب، جسدي النحيل يأخذ نصيبه من الضرب واللّكم، كدمات تطبع على وجهي من عنف الأشقياء، بعضهم تزيّن له نفسه بتكرار الصفع والبكس عدة مرات بتقمص دور لكمات محمد على كلاي وضربات فريد شوقي، ضحية عنف وحشي والجوع ينهشني نهشا، «جوع وضرب جموع»، مصروفي طوال اليوم ”قرشين“ وإذا ضاعا أو نهب مني أكون شبه صائم إلا من بلع لعابي.
أفرُّ فرار العبيد من ساحة العلم والحارة والبيت، أهرب من اللجج العاصفة والمرسى فريق الأطرش، مرتع طفولة أمي، أغدو طائرا بجناح الفرح، طليقا احلق، بعيدا عن غلظة بعض المعلمين وحبسة المدرسة ورهاب كلاب السوق، كم مرة هربت، والتجأت إلى ديار أهل أمي، أختبئ بين بساتين خيلان والدتي ورجل خالتي ومعامرة عمي محمد حسين زوج جدتي أبو جاسم سالم، رجل قوي البنية جميل الطلعة مفتول العضلات، قضى عمره في الحرث والزرع متنقلا بين معامير كثيرة، يعمر مكان ويذهب لآخر، من نخل لنخل، يعتبر أحد الفلاحين الذين حرثوا منطقة الجبال، أنبتها بفسائل جديدة وبذرها بالبطيخ واستخرج منها خيرا وفيرا، وقبله خال والدتي حجي حسن بن زرع وعلامة مزرعته ”الغرافة“ التي يرفع بها الماء عبر ”دلو“ من جوف ”السيبه“، ويدفقه إلى مجاري الماء ”السمط“ لتروي زروع البطيخ والنخيلات الجديدة وفسائل لم تكبر بعد، أدركت المزرعتين ورأيتهما بين عامي 1971 و1972، ليت عندي كاميرا لأصور حقول البهجة، التي آنستني طمأنينة بكل ما مر بي من قسوة ورهبة.
منطقة الجبال هي أبعد نقطة مزروعة شمالا ضمن مزارع فريق الأطرش، على مقربة من غابات المنگروف ”القرم“ وتفرعات خور البحر.
عمّي لم يكن وحده في تنقلات المزارع التي قام عليها، كان يعاونه أولاده جاسم وعباس، الأول أمه زهراء بنت حجي يوسف بن يعقوب من سنابس، توفيت شابة، والثاني والدته السيدة معصومة آل نصيف، ومعهم خالي حسين هبوب، شبان تنافسوا في جزّ القت وصعود النخل، وإطعام الدواب، النارجيلة تلازم عمي والدخان من نصيب الثلاثة، والراديو يتنقلون به من غصن إلى آخر، تسلية أنغام واستماع أخبار.
حين تحل العطل المدرسية أتنفس الصعداء، فالوقت مجزي للانطلاق شمالا، بيت أمي العودة هو الملفى والعيش بأمان، ومزرعة عمي أنفاس راحة بال، ذات صباح أحمل الراديو لخالي وأقربه منه كلما تحرك بين جزّ ”الگت“ وري ”الضواحي“، التقطت أُذني خبرا مفاده ”هنأ الرئيس الجزائري هواري بومدين رئيس الإتحاد السوفيتي ليونيد بريجنيف بمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر“، لأول مرة أسمع هذه الأسماء، ولم أعي بعد مفهوم الخبر، أفهمني خالي بأن الأخبار تخبرنا ماذا يحدث في العالم.
كنت أغبط خالي بأنه غير مرتبط بعالم المدرسة نهائيا، لا حبسة بين جدرانها من الصباح إلى الظهر، ولا أحد يعاقبه على نسيان واجب أو تسميع نشيد، لكن الحقيقة بأن خالي يشكو حاله ويندب حظه العاثر بأنه لم يحظ بالدخول للمدرسة علما بأنه يكبرني باربع سنوات، لم يأخذ أحد بيده لمقاعد الدرس، اليُتم حرمه من ذلك، فقد مات والده وعمره 40 يوما، تحمله أمي وتدور به على بيوت فريق الأطرش لكي يرضعوه، ارتوى من صدور خمس نساء تقريبا، جزاهن الله خيرا، بالإضافة لشرب حليب البقر، خالي رضع العزم والإعتماد على النفس والمثابرة والكفاح، نبيه لماح قوي البنية.
ذات مرة فرّ عجل ضخم من زريبة معامرة عمه ”نخل لفليه“ لحق به سريعا وبعد مطاردة مضنية أطبق عليه بين كثافة أشجار التين واللوز، أمسكه من رقبته والأنفاس متقطعة، خارت قوى الاثنين من شدة الركض، يجره جرا والحركة بطيئة إلى داخل الحضيرة، ربط رجله بحبل المحبس ”الرسن“ المغروس بقطعة حديد في الأرض، أحيانا ينفك الحبل ”يفتل“ من كثرة الدوران والمزاحمة نحو الأكل بتقارب الأجساد وهيجان رغبات الفحولة.
يخبرني خالي بأن المزارعين ليسوا متساوين في الشطارة، هناك المقدام الذي لا يهاب صعود النخيل، بينما آخر لا يجرؤ حتى على ركوب نخيلة، إن صعود النخيل وبالأخص العاليات يحتاج من الراكب مهارة وجسارة وقدرة فائقة وتحمل، ليس الصعود بالسهل، الكرّ لوحده ثقل وحركة شده وارتخائه فن وتعلق الراكب لثوان في الهواء إلا من ثبات أرجله على درجات الجذع يعد خطرا، العملية تحتاج إلى مرونة وشدة بأس صعودا والخفة نزولا بحذر، كم من راكب انقطع به حبل الكر وهوى أرضا وفارق الحياة، ثمة قصص وحكايات مؤلمة لأسماء معروفة وأقارب قضوا نحبهم من أجل رزقهم، شهداء ارتوت الأرض من دمائهم وردوا كيد الغرباء.
إن سعي الرجال في النخل والبحر لم يكن سهلا برغم ما حدث من مآس من غدر الموج وانقطاع الكر إلا إنهم نذروا حياتهم للعمل، لم يتوقفوا ولم يكسلوا يوما، كدح وشقاء وصبر وعطاء وتضحيات جسام،
تقول أمي:
”چلب لمعسعس ولا أسد رابض، ويش فايدتك تكون قوي لكن خايب، من وين يجيك الأكل، من وين يجيك الرزق، الدنيا تبغى ليها مراجل“ هكذا كان ديدن الأولين، ينتفسون العمل، وكما قيل شرف الإنسان العمل، وقيمة كل إنسان ما يعمل.
ثمة مزارع عديدة تنقل فيها عمي محمد حسين أبو جاسم سالم، يطيب له مكان زمنا وينتقل لآخر، تنوع معامير ضمن مساحة فريق الأطرش، لم يتخل عن هذه البقعة المحببة إلى قلبه فضلها دون زروع جزيرة تاروت، مزارع عمرها عبر محطات عمره منذ أن كان يافعا إلى آخر يوم من حياته وهي على التوالي:
1- ابو شليبي
2- لجبال
3- لحياله
4- لجبال - مرة ثانية -
5- أم الشعير
6- صلخ أبو لعظامه
7- الصلخ الصغير
8- المسرح
9- لفليه، نخل «لفلية» وهو من أجمل المعامير لتنوع مزروعاته وكبر مساحته.
وآخر مكان قام عليه نخل «أم لقرون» وبينما هو قائم على هذه المزرعة صرعه مرض مفاجئ في معدته لعدة أيام وقد رأيته بنفسي يقول إلى أمي العودة وهو خارج من البيت متوجها إلى مستشفى السويكة، ”هالمرة روحة بلا رجعة في أمان الله، ابروا ذمتي“، كانت عيناه العسلية جاحضة وجفونه منتفخة، والوجه حفرته أوجاع السنين، بعد أيام من رقوده على السرير الأبيض انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 80 عاما، غادرنا عمي أبو جاسم يوم 29 شعبان سنة 1407 الموافق 1987، تاركا المحش والمنجل مغروسين في جذع نخلة، زرع ذبل لبعض الوقت، كأنه استشعر حزن الفقد ليد روته أياما وسنين.
التنقل بين المزارع لم يتفرد به عمي محمد حسين رحمه الله بل لازم العديد من الفلاحين، يقومون على استصلاح نخل ما لسنوات معينة ثم يغريهم آخر فيذهبون لعماره، وأيضا الارتحال ليس خيارا، ولكن أشبه بالمساومة بين البقاء أو الضياع، لأن الغالبية العظمى من هؤلاء الفلاحين البسطاء ليسوا ملاكا لمعاميرهم! هم أشبه بالأجراء عند الملاك، الذين بيدهم المال والجاه، كبار استحوذوا على مساحات كبيرة اشتروها استثمارا للمسقبل، والبعض قبض على أراض بياض، وهناك ملاك اغتنموا ظرفا تاريخيا فاتتهم الهبات على طبق من ذهب، كل يغري المستضعفين لبضعة سنين لحرث البساتين واعمارها، مقابل بيع المزارع حصاده وتزويد المالك ببعض المنتوجات وقدر محدد من المال، قد يكون زهيدا، لكن الفلاح لا يملك قرار بقائه، فهو مرهون بمزاجية المالك.
لو كان بيدي لطبّقت أحد المفاهيم الاشتراكية ”الأرض لمن يزرعها“ وقبل ألف سنة تحدث الفيلسوف ابن حزم الاندلسي بأن ”الأرض لمن يفلحها“.
أين الفلاحون من هذا المفهوم المنصف، تلك زفرات ضائعة وآهات مكبوتة، فلّاحون لم يظفروا بشيء، عمروا مزارع فريق الأطرش طولا وعرضا وجعلوها بهذا الشموخ الفتان، من ملك منهم نخلا يعد واحد في المائة، كادحون كانوا وقود البستنة.
ومع شديد الأسف والغصة في الحلق بدأ الزحف العمراني يغزو المساحة الخضراء منذ أكثر من خمسة عشر عاما، تشوه المكان واطبقت عليه الصناديق الإسمنتية من كل الجهات.
لمن أبوح شكاوي وأسترجع وقفات الذكرى، بعد أن تآكلت فراديس الجمال، ففيها أنفاس حرية طفولتي وأنس مجتمع طيب القلب يحنّ اليها باستمرار، أحِّن لأرض أطعمتني من جوع وآمنتني من خوف.